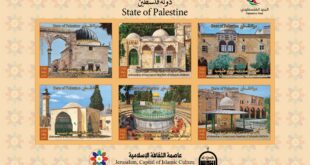في ذكرى أسبوع على رحيله المفجع (الأخبار 10/3/2018)، يجتمع أصدقاء وعائلة عازف العود اللبناني الشاب عماد حشيشو (1988 ــ 2018) في صيدا في وقفة تحية ووفاء. عند الـ 5:45 من بعد ظهر اليوم، سيلتقي هؤلاء قرب منزل العائلة في صيدا (ساحة القدس)، وتحديداً في مكان الحادث المفجع (مدخل صيدا مول) لوضع الورود وإضاءة الشموع إحياء لذكرياتهم معه.
في هذه المناسبة، تفرد «الأخبار» صفحاتها لأحباء الراحل من موسيقيين وفنانين ومبدعين وعازفين وصنّاع المشهد الموسيقي البديل في بيروت… يستذكرون مشوارهم معه وشخصيته المأخوذة بهاجس الفنّ حتى لحظاته الأخيرة.
الأخبار: ادب وفنون
ولد من أولادي
عرفت عماد منذ صغره وعمره خمس سنوات، من خلال العلاقة التي تربطني بالعائلة وخاصّة الوالد محمد حشيشو ووالدته سناء. منذ ذلك الحين، كان عماد يترعرع بين التنوع الفكري الثقافي والموسيقي الملتزم بقضايا الشعوب الإنسانية. كان يراني دائماً هو وشقيقته الوحيدة نيفين في جلسات مع الأهل، فرح، حب وموسيقى وأغان. مع الوقت، طلب مني والده أن أهتم به موسيقياً.
بقدر الإمكان، تابعت هذا الموضوع رغم صعوبة المسافات في ذلك الزمن الجميل. فاشتغل عماد على نفسه وكان قادراً على تحقيق جزء كبير من أحلامه. كان متخصصاً أصلاً في سماع الشيخ إمام. بعد فترة من الزمن، أصبح عماد قادراً على تحقيق أحلامه الفنية المتنوعة من خلال اتكاله على ذاته وهذه ميزة لا يستهان بها. وبعدما قابلته بعد سنوات عدة في شارع الحمرا في «مسرح المدينة»، فرحت به كثيراً وشجعته وكنت أتابعه دائماً من حيث لا يدري بمشاركاته الفنية في «مترو المدينة» بين الفينة والأخرى. كنت أدعوه الى جلسة حوار حول المتغيرات والأوضاع الحياتية طبعاً. كان يأخذ رأيي دائماً لأنه يعرف من أنا. حين طلبت منه أن يشارك معي في فرقة «الرحالة»، كانت لحظة حلم بالنسبة له خاصة مع إخوانه، أحمد الخطيب، سماح أبو المنى، علي الحوت، الذين انضموا قبله إلى الفرقة. قلت له بأن يأتي بآلة موسيقية جديدة هي «الفيولونسيل» التي أحبها كثيراً وشجعته أن يكمل عليها لأنها تشبهه. وعلى هذه الآلة، بدأنا التمارين ثم الأمسيات الموسيقية التي كان آخرها في «مسرح المدينة» قبل رحيله بخمسة أيام. وهكذا حصل. لذلك أعتبر أن ولداً من أولادي رحل. لكن سأكمل مع إخوانه المستمرين في هذا الفضاء الواسع الجميل.
هل يغفو القمر؟

يختفي جسده النحيل خلف العود، يترك ابتسامة دائمة، وعينين تشعّان بالطاقة الجميلة. يلقي برأسه على العود وتبدأ الموسيقى. هذه الصورة لم تتغيّر منذ عرفته عام 2007. لم يكن قد أتمّ التاسعة عشرة من عمره. لم تختف الابتسامة ولم يخفّ وهج تلك الطاقة.
ظهرت موهبة العزف باكراً لدى عماد حشيشو لكنّه حلّق سريعاً. من البدايات مع أمل كعوش إلى «ربيع بيروت»، «ميّال»، «أصيل»، «الراحل الكبير». أصبح حضوره دائماً تقريباً في عروض «مترو المدينة» الموسيقية والمسرحية.… ليس فقط احترافه العزف، الذي مكّنه من المساهمة في هذه المشاريع المهمّة، بل شخصيّته أيضاً.
قلت له ذات مرّة «هذا ما كان ينقصني… أن أجد اسمك كلّما أردتُ الكتابة عن مشروع موسيقي جديد». كان يعود ليخبر أصدقاءه بكلّ جديد، يُسمعنا ما تعلّمه مع مصطفى سعيد، ما عزفه مع غسان سحّاب، أو ما يحضّره مع خالد صبيح و«الراحل الكبير» ومع عائلة المترو. المشاريع والأدوار كانت كثيرة، العزف على العود، الغناء التمثيل والعزف على التشيلو. الأثر الذي تركه عماد في الأعمال التي شارك فيها على المسرح أو في الإصدارات، كبير بالنسبة لشاب رحل بهذه السرعة.
الجانب الآخر والمهمّ جداً في حكاية عماد، هي صورة الفتى الضحوك، يحمل عوده أينما ذهب، يزرع الموسيقى والنغم الجميل في كلّ منزله يزوره وفي كل جلسة حميمة. لا يبخل على أحد، في منزل الأصدقاء وأصدقاء الأصدقاء وأهل الأصدقاء. يطلّ بعوده ويعزف ما استطاع من الطرب الثقيل الذي يستهويه ويتفاعل معه بقوّة وتأثّر و«يا سلام». يتفاجأ كثيرون بصغر سنّه بالمقارنة مع مخزون الطرب الذي يملك. شربنا من هذه السهرات والجلسات موسيقى عماد حشيشو حتى الثمالة، لم نشبع بعد.
من عَزَفَ الى جانب عماد على خشبة المسرح، يعرف قيمة تلك الطاقة والروح الحلوة التي ينثرها حضوره وتواصله الدائم.
إلى جانب عائلته الصغيرة في صيدا، سناء، محمد، نيفين وراني وناجي وكيندا، لعماد عائلات كثيرة في بيروت. يوم الجمعة الفائت، اعتقد بعضهم أنّ خبر رحيله دعابة ثقيلة من فرقة «الراحل الكبير». ليتها كانت. مؤكّد أنّ من عرفه لن يبتلع رحيله. لكن إلى جانب الكمّ الكبير من الألم، تتردّد ضربات عوده وصدى ضحكاته العالية في منازل الأصدقاء، في مسارح بيروت وفي شارع الحمرا.
كميّة كبيرة من الفرح التي لا تنتهي تركها عماد حول من جمعهم حوله. كان هذا واضحاً من خلال اللقاء الذي جمعنا مع أصدقائه وعائلته حول صوره مساء الأربعاء. لا تأتي سيرته إلّا ونضحك ونبتسم. عزف الأصدقاء وغنّينا ما يحب أن يغنّيه عماد ويعزفه. وطلب إلينا أهل عماد أن نلتقي مساء اليوم لنكسر جميعاً حاجز ذلك المكان الذي وقع فيه الحادث، ويبعد عن منزله ثلاث دقائق فقط. نضع وردة ونضيء شمعة كي لا يبقى أي حزن في أي مكان أو أي ذكرى. لأن الحزن لا يليق بذكراه.
5 آذار 2018
عرفت عماد كصديق وكموسيقي عن كثب لأكثر من ١٠ سنوات. أن أكتب عنه يعني زيارة كلّ ما اختبرته موسيقيّاً معه. مجرّد التفكير في الموضوع أرهقني. لذلك، وتفادياً لهذه المهمّة الشاقّة، قررت أن أكتب عن لحظة واحدة في حياة عماد. هذه القصّة ليست من تلك الأساطير التي تظهر فجأة خلال جلسات العزاء، فيكون الميت قد أنهى السبعة وذمّتها في حياته، ويأتي الجار معزّياً فيزفّ للعائلة أنّ المرحوم كان قد أسرّ له برغبته أداء مناسك العمرة الشهر المقبل. لا، هذه القصّة حصلت منذ أسبوع، وقد يأتي يوم ليس ببعيد نجد فيه طريقة لاستكمالها.
منذ سنتين، حتّى ذلك اليوم الذي غفا فيه خلف مقوده في ٩ آذار ٢٠١٨، كان عماد مسكوناً برغبة شديدة أرسلته في بحثٍ عملانيّ مع عوده. كانت رغبته ليست بالطلب الفريد، وهو إيجاد طريقة معاصرة لقول ما يريد موسيقيّاً من خلال آلته. هذا حقّ لكل موسيقي، لكن للأسف، فإنّ محاولة التجديد في موسيقى العرب هي كمحاولة التجديد في أديانهم؛ مهمّة صعبة وعنيفة، وتُواجَهُ بتكفيرٍ من الجموع الوفيّة لعفن جيفها. هذه الرغبة متوقّعة لدى موسيقي كعماد، المتأثّر عميقاً بتجارب مختلفة في الموسيقى العربيّة. كان يرى في عمل أستاذه وصديقه مصطفى سعيد مقاربةً تجديديّةً شاملة، مؤمناً بأن تجربة مؤسّس «أصيل» لن تكون لحظة عابرة في حياته، إضافةً إلى جموح الشيخ إمام عيسى في طريقة «ضربه» للأوتار، وغضّ النظر ــ من حينٍ إلى آخر ــ عن النظافة في أداء الأبعاد اللحنيّة على حساب ما هو أهم، ألا وهو العمل الموسيقي بحدّ ذاته. كلّ هذا كان نقطة بداية لدى عماد الذي فُتحت عيناه على احتمالات هائلة، حُرِمَت الموسيقى العربيّة منها بسبب تركيبات جماليّة زائفة آتية من قِيَم القرن المنصرم، وتدّعي فناً لا نجد فيه سوى الطهارة والجمال والهدوء، محاكياً واقعاً لا علاقة له به. لهذا كان عماد يتحمّس عندما كنّا ننهال بأحاديثنا سباباً على هذا الكذب في موسيقات تدّعي تمثيلنا، ورغبته في إيجاد طرق في اللفظ واللحن والجَرْس على العود تشبهه وتشبهنا، مصدرها عشقه لهذه التجارب، وحقده على زيف تلك الطهارة. هذا البحث قد يكون من أصعب الأسئلة المطروحة الآن في جدل التجديد لدى الموسيقيين العرب. ودليلاً على ذلك، كلّما كان يمرّ شهر أو شهران، وعلى مدى آخر سنتين، كان يظهر الحاج مع عوده، بادياً عليه التردّد والحذر، ويقول لي أو لأي من الأصدقاء «ليك اسمعلي هالجملة» ويعزف لحناً مختصراً، متأمِّلاً أن نقول له إنّه أخيراً أصبح على الطريق الصحيح لإيجاد ما أراد. كلّ مرّة كان يعزف عماد لحنه ويسكت، وننظر إلى بضعنا ونقول «لا.. مش ظابطة». علماً أنّ كلّ مرّة كان عماد يقدّم نموذجاً لـ «نتيجة بحثه»، كان السماع له ممتعاً ومطرباً، لكن كنّا نجد فيه ما نجد في أي تقسيمٍ تقليديّ لعوّاد ماهر كعماد، حتّى إن شخصنة عماد لعزفه كان يحوّل ما هو تقليدي وجميل إلى مثيرٍ وملموس، وهذا شعورٌ نادرٌ في أداء الموسيقات التقليديّة عموماً في هذا الزمن. مع ذلك، لم تكن هذه النتيجة التي كان عماد يبحث عنها. كان يريد أن يرى في عيون سامعيه بريقاً يقول له «وجدتها يا أخو الـ…!!!». سنتان وعماد لم يتوقّف عن قول «ليك اسمعلي هالجملة». لم يملّ أو حتّى يُحزَن من سماع «لا.. مش ظابطة». أليس هذا الدليل الأقوى على صدق عشقه لما يفعل؟ كرجلٍ مغرمٍ بامرأة بسبب خطاياها ومحاسنها على السواء.
مساء ٥ آذار ٢٠١٨، كنّا مع خالد وأحمد وساندي ولارا في الاستديو لدى جواد. وقبل بداية التصوير بثوانٍ، شعرت بيد عماد على كتفي وسمعته يقول «ليك حاج؟ اسمعلي هالجملة». وبدأ بعزف لحنٍ لم يدم أكثر من ١٥ ثانية. كان لحناً معقّداً، ليس بتقنيّات العزف، بل بما يطرح موسيقيّاً، وما يحيلنا إليه من صور من حياتنا اليوميّة، من خلال تقنيات في اللفظ، واستقصاده لجَرْسٍ وأصوات لم أسمعها قبلاً صادرة من عود، إضافة إلى المكوّن الأساس، وهو استخدامه لأبعاد زلزليّة (مسافات متوسّطة) وملوّنة (مسافات كبرى وصغرى) وقويّة (مسافات كبيرة وصغيرة). وكلّ واحدة من هذه المسافات وظّفها من خلال قيم مختلفة، منها تفاصيل أبعادٍ موجودة في مقامات فترة النهضة، ومنها ما لم أسمعه أو حتّى أدرسه من قبل، أقله ليس في هذا الشكل، مع تقنين في الزخرفات، وبساطة في الأداء. أقسم أنّي لم أسمع شيئاً كهذا من قبل. أستدير إليه وأسأله على عجل وبصوتٍ خفيت لا مبرّر له، كمن اكتشف كنزاً: «هل أسمعتها لأحد؟؟ هل أسمعتها لمصطفى؟!». فقال لي «لا بعد.. هذا الشيء من يومين فقط، سأسمعها لمصطفى الجمعة في تمرين أصيل». هنا نسمع لارا وهي تطلب منّا أن نتّخذ مواقعنا استعداداً للتصوير، فأعود لوضعيتي الأساسيّة وعماد جالسٌ خلفي. قبل التصوير بثانية واحدة، أدير رأسي لعماد وأقول له: «وجدتها يا أخو الـ…!!!» وبرقت عيناي.
في اليوم التالي، اتصلت به وحدّدنا موعداً لجلسة سماع وتجريب لنفهم مدى خصوبة ما وجد عماد في عوده. كان الموعد ليل ١٥ آذار، وكان الحديث عبر الهاتف حماسيّاً لدرجة طفوليّة. لم يسمعها مصطفى، ولا خالد، ولا غسّان سحّاب، ولا علي الحوت. سمعتها أنا لأنّ مكان جلوسي في تلك اللحظة في الاستديو صادف مباشرة أمام عماد. رحل عماد قبل لقائنا بمصطفى بأسبوع تماماً. قد نجد مقتطفات لهذه الجملة «النموذج» على هاتف عماد، أو قد يكون قد أرسلها لأحد، كما كان يفعل أحياناً. ولو فقط استطعنا أن نفهم السلّم الذي عمل عليه، نكون قد استفدنا من وأنقذنا ما بذل عليه عماد ساعات وليالي لن تعوّض.
كم هو مليء بالأحداث هذا الأسبوع في حياة عماد. في ٥ آذار ٢٠١٨ وجد داخل عوده أخيراً ما قضى سنتين من عمره باحثاً عنه. في ٦ آذار ٢٠١٨، أنهى تصوير دور البطولة في فيديو لـ «الراحل الكبير»، هو الذي كان يحلم بدخول عالم السينما والتمثيل. في ٨ آذار ٢٠١٨، حصل على تأشيرة دخول إلى مصر التي طوشنا برغبته بزيارتها منذ سنين. وفي ٩ آذار ٢٠١٨ غفا عماد خلف مقوده.
حبيبي يا حاج
أكتب هذه الكلمات وأنا ما زلت لا أصدق ما حدث فجر الجمعة الفائت. لقد تقابلنا للمرة الأولى في عام 2006 أو 2007، لا يهم متى. أتعلم لماذا؟ لأن علاقتنا كانت من تلك التي لا تشعر أنك بحاجة لأن تضعها في إطار زمني.
كان يجمعنا العديد من الاهتمامات المشتركة، لم نكن نتقابل بشكل يومي، ولم أكن أعلم أنك كنت موجوداً في تفاصيل حياتي إلى هذه الدرجة.
كان لديّ العديد من التساؤلات عن عدم دخولك في نظام الحياة البائس الذي ندخله من دون إرادة، كلٌّ منّا بطريقته.
عن أي عماد يمكنني أن أتكلّم، عن الإنسان؟ عن الموسيقي؟ عن الضاحك دون توقّف؟ عن راسم الضحكة على وجه كل من عرفه عن قرب وعن بعد؟ عن الفيلسوف؟
نعم كنت فيلسوفاً. كانت مقاربتك للحياة فريدة، لم نكن نفهم العديد من كلامك. لكننا بدأنا منذ رحيل جسدك.
لطالما شعرنا أن روحك قديمة لكنها شابة، روح لديها الكثير من الخبرة والتجربة في جسد جديد. جسد أراد القدر والظروف أن يكون محطة في حياتنا.
لم نعمل سوياً في الكثير من المشاريع، لكن المشاريع التي جمعتنا كانت من الأعزّ على قلبك، وقلبي. كنت أتابعك؛ أتابع تطوّرك الموسيقي الذي وصل إلى درجة أن والدي يظن تقسيمتك في أسطوانة «شرقي» هي من أداء مصطفى سعيد؛ مثلك الأعلى على آلة العود وفي الموسيقى على الإطلاق.
لا أعلم إذا أخبرتك بأنني كنت أندهش من دقة أذنك الموسيقية؛ ليست أذنك فقط، إنما شخصيتك الموسيقية التي كنت وما زلت على يقين أنك لم تسمعنا منها إلا نسبة صغيرة.
كنتَ قد بدأتَ بترتيب أفكارك الموسيقية، بدأت بالتفكير في مشروع لم تسنح لنا الفرصة للتكلم في تفاصيله. مشروع يعبّر عن شخصيتك من الألف إلى الياء. شعرت ذلك من الثواني التي أسمعتني إياها في تمارين حفلتنا الأخيرة. ظننا الوقت أمامنا، قمنا بتأجيل موعد حديثنا عن هذا المشروع مرات عدة لنحدد الموعد الأخير الذي انسحبت من الدنيا المادية قبل حصوله.
ظننت أن الوقت أمامنا لأخبرك أموراً كثيرة كنت أشعر بها ناحيتك، لكنك كنت تعلم؛ كم من مرة أخبرتنا أنك لن تكون في النهايات. وننهي الحديث بضحكة؛ كان شيئاً بداخلنا لا يريد تصديقك، لكنك كنت تعلم.
سلامٌ لروحك الطاهرة
سلام يا حبيبي، سلام يا حاج
خفيف الروح

من الصعب، إذا لم يكن من الظلم، الكتابة عمّن فارقنا. قد نلبسه موقفاً من دون مناقشته فيه أو من دون حفظ حقّه في الرد… ولكن عماد بالتحديد لا يعنيه هذا الحق. ببساطة لن يردّ. ليس لأنه فارقنا وهو الحاضر في تفاصيل حياة كثيرين منا، ولكن لأنه لم يكن يظهر جرحه أو انزعاجه حين يُقال عنه شيء لا يوافق عليه.
قد يبدو من الكلام هذا أنّه «جوّاني» لا يظهر مشاعره أو أنّه عابث بالحياة. لا. هو الذي طالما شارك مشاعره باستمرارٍ، مع كلّ من حوله، لكنه عن قصدٍ ربّما أو عن حكمةٍ ما كان يحصرها كلّها بالحب. وهو المتناقض الذي يمسك بطرفين باستمرار، عبثه وعشوائيته من ناحية، وانتباهه الى أصغر التفاصيل وأدقّها من ناحية أخرى… في الموسيقى خصوصاً.
خفيف الروح هو. يطير حولنا. في تفاصيل حياتنا. يختفي. يظهر. يتكلّم كثيراً. يضحك كثيراً. يُضحك كثيراً. ويصمت كثيراً أيضاً. يستيقظ باكراً جدّاً… قد يمضي نهاره في سماع ما سجّل من جلساتٍ موسيقيّة في الليلة الفائتة أو قد يمضي نهاراً كاملاً في عدم فعل أي شيء.
خفيف الروح هو. نحارُ إذا كان سماعنا لعزفه على العود هو أجمل ما فيه، أم التأمّل بوجهه الضاحك وهو يعزف موسيقى يحبّها، أم أنّ الأجمل فيه على الإطلاق هو صوته يصدح «الله… ويا سلام» لسماعه تقسيمة أو غناء لمصطفى سعيد أو مقطوعة جديدة لغسان سحاب.
خفيف الروح هو. يستطيع أن يذهب من تمارين فرقة «أصيل» أو مجموعة «شرقي» بكلّ ما تحمله هذه التمارين الطويلة من سلطنة وتركيز، ليرقص ويغني ويهرّج على مسرح «المترو» في حفلاتٍ مختلفة. وكان يحبّ هذا كلّه. ويتقن هذا كلّه. ويُشعر الكلّ أن ما يفعله في تلك اللحظة هو أكثر ما يحبّ عمله على الإطلاق.
خفيف الروح هو. يشبه شعر عمر الخيام في رباعياته وكان يكونه في حالاتٍ كثيرة. بل يتماهى مع ما كتبه حبيبه الخيام:
«لا تنظرنّ إلى الفتى وفنونه… وانظر لحفظ عهوده ووفائه
فإذا رأيت المرء قام بعهده … فاحسبه فاق الكل في عليائه»
وخفيف الروح هو. الحبّ مضمونه. والحبّ أبديّ. لا ترقد روحه بسلام إلّا لأنّه عاش بسلامٍ وبتصالحٍ مدهشٍ مع النفس.
محمد وسناء: هذه بضاعتكما رُدّت إليكما
ثمّ علمتُ أن الأصدقاء القيمين على الصفحة الثقافية في الجريدة كانوا أصلاً في صدد التفكير بتخصيص ملفّ عن عازف العود المحترف والمغني الخلفيّ والممثّل في خطواته الأولى، الذي كان أساساً لا غنى عنه في جملة من المشاريع الفنية في بيروت تراوحت بين التقليد الموسيقي للقرن التاسع عشر الأحبّ إلى قلبه مع مصطفى سعيد، والإنشاد الديني، والأغاني المصريّة في منتصف القرن العشرين وما بعده مع نعيم الأسمر، واللحن الثائر المتآمر على الواقع للشيخ إمام مع ساندي شمعون، والغناء الشعبي المصري مع فراس عنداري، وغير ذلك من ألوان النغم الباحث عن فرح أو معنى ما بين رنين الأوتار وقرع الطبول..
وبعد انقضاء أيام طوال على فراق عماد شابها ما شابها من مظاهر الحزن المودي بأصحابه إلى حافّة الجنون، لا أخفي القول إن الرغبة في الكتابة عن عماد قد خفتت بل صارت ثقلاً أود، كما الكثيرين ممن عاشوا معه أيام الغبطة والتوتر والفرح والقلق، أن يطوى.. وأن ينتهي زمن الحداد، لنعود إلى ما بقي لنا من أيام في هذه المسخرة الكبرى التي نسمّيها حياةً سعيدة أيها السادة.
لكن رغبة صارت طاغية الآن، وهي حديث لا ينتهي إلى محمد حشيشو وسناء الدبّاغ، الوالدين الحبيبين لرفيقنا الحبيب، وصار التأمل في هذه الشجرة الطيّبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء حديث كلّ رفاق عماد وأحبته.
وإذا كانت الوالدة الحبيبة سناء لم توفّر دمعة وصوتاً على ولدها الراحل إلى حيث نعلم أو نظنّ أننا نعلم، ثم أدهشت جمع الأصدقاء المعزّين بإبدالها البكاء بما حفظت من أغاني الثورة والسخرية متمايلة على أنغام عود سامي حوّاط وباقي الرفاق ومعزّية من جاؤوا يعزّونها بصوت شجيّ زاد التدخين من سحره، فإن الوالد الحبيب محمد قد أسر قلوب الجمع بوجه صلب يختزن في ملامحه السمراء نضالاً صلباً عتيقاً تفضحه رغماً عنه عينان دامعتان بخفر، وقبضة ترتفع مرتجفة وهو يردد مع رفاق عماد «نسلك طريق ما لوهش راجع والنصر قرّب من عينينا».
«عسى أن يكون قد ساهم بقطرة في نهر الإنسانية العظيم» بهذه الكلمات المرتجلة، وبشفتين مرتجفتين وعينين صلبتين تختصر حمرتهما كلّ ما في الدنيا من وجع، نعى الشيوعي العتيق محمد حشيشو ابنه عماد أمام جمع كبير من الأصدقاء والموسيقيين والمسرحيين في تجمّع أقيم في بيروت الأربعاء، كشف كمّ أن عماد كان حلقة وصل خفيّة بين أجواء مختلفة متضاربة متباينة وربّما متصارعة، في الذائقة الموسيقية ونمط العيش والفكر السياسي، ليخرج صديقنا المخرج هشام جابر عن صمته الحزين في لحظة اختلطت فيها عنده الفاجعة بالسخرية وشيء من الكحول ويصرخ: «يا ناس، الحشيشو لكلّ الناس!».
في الأيام الماضية، اكتشفنا جميعنا أن الدائرة التي تعرف عماد أوسع مما كان أي منّا يتصوّر، لكن قلّة منا ربّما تعلم من أين تفرّع هذا الغصن الذي أزهر فنّاً وطرباً ومزاجاً عالياً وصلابة في شقّ طريقه، واستهزاء بالدنيا وما حوت، وشوقاً لمعرفة أسرار وجودها ومن أوجدها.
عماد هذا هو ثمرة عائلة امتهنت النضال السياسي من بابه المودي إلى الفقر والاضطهاد، ودافعت بالدم عن صيدا، ولمّا راح الاحتلال، انكفأت إلى الخدمة الصامتة والدفاع عن قضايا الفقراء.
عماد هذا الذي شاهدناه عازفاً ومغنياً في أي عرض موسيقي أو مسرحي لا يبتغي الربح بقدر ما ينشد الفرح والطرب والثورة والتمرّد وتحدّي مأساة الحياة، إنما هو ابن هذه الشجرة التي ما زالت تبحث في جذور الأصالة عن معان متخيّلة للمستقبل.
عماد هذا الذي ربّاه والداه على الثورة لم يوفّرهما من ثورته، فكان ابنهما حتى في تمرّده على رغبتهما في أن يبحث عن استقرار وظيفي أو تقدّم دراسي.
نهل عماد من هذه الدنيا حتى شبع وغادرها كما شاء، فيما نحن نعدّ الأيام لا نحصي لتوالي الليل والنهار وتعاقب السنين عدداً.
عماد هذا الذي أضحك كثيرين وأبكى كثيرين، إنما هو ثمرتكما يا سناء ويا محمد، وقد شاء القدر، أو الطبيعة كما تسمّيه، أن يضع اللمسات الأخيرة على ملامحه، ليصبح خلقاً تامّاً وبضاعة كاملة.. .هي بضاعتكما يا محمد وسناء، وقد ردّت إليكما قمراً مكتملاً كان ينبغي أن يغيب حتى نراه ونرى بعضنا بعضاً.
 موقع هوا لبنان
موقع هوا لبنان