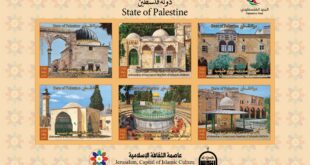شربل فارس: نحات «متمرّد» تلاحقه لعنة الفراعنة

التاريخ:
يعتبر النحات والتشكيلي والناقد اللبناني شربل فارس من رواد الحركة الفنية في وطنه، ومن الذين تميزوا بغزارة إنتاجهم وتفاعلهم الدائم مع المحن التي واجهها لبنان والوطن العربي، سواء عن طريق النحت أو الرسم المترافق بالكلمة. وقد فردت المطبوعات لرسوماته وكلمات صفحاتها، كما تم تكليفه بإنجاز العديد من المنحوتات والنصب تخليدا لذكرى أشخاص ومناسبات تاريخية ووطنية.
العامل المشترك في معظم أعمال شربل فارس الفنية من رسم ونحت، هو المرأة المتجسدة بزيها التراثي الطويل. فهي إما رمزا للأرض أو للشموخ والقوة، أو للتمرد على الواقع والنضال، أو للاحتواء والسكينة. وقال في لقاء مع «مسارات» خلال زيارته العائلية لدبي عن وجود المرأة الطاغي في أعماله، «استلهم معظم أعمالي من المرأة. ولا أدري إن كان ذلك لأني محاط بالمرأة في إطار الأسرة، أم لأن جماليات تكوينها في الخطوط والمنحنيات واللباس هي التي تأسرني. فثوب المرأة الشرقية بالمفهوم التراثي فيه ليونة الخطوط وتحديه لمساحة الفضاء. ومثالا على كلامي جماليات صورة الثوب الشرقي للمرأة في مواجهة ريح عاصفة.
قدمت في ثلاثة معارض أولها عام 1998، أعمالا مستوحاة من حرف النون وصداها، فحرف النون النسوي الذي يدل على الصفاء هو رمز التجلي عند المتصوفين العرب المسلمين، الذين كان يرددون هذا الحرف في التكايا على مدى يقارب من 24 ساعة، حتى وصولهم إلى حالة التوحد. حضارتنا محورها النون الخط المنحني الملتف الحنون، تراثنا وتقاليدنا ملتفة حوله حتى هندستنا كالقبب والمآذن وطبيعتنا كالكثبان والفيافي والهضاب.ويضيف «عملي على النون لم يعتمد على السلفية، بل حاولت تجديده والوصول من خلاله إلى أعمال معاصرة تتفاعل مع الحاضر». وعن تجربته مع الفن التركيبي الحديث، قال لدى سؤاله عن تعريف هذا الفن بداية، «الفن التركيبي، عمل مشهدي مركب يعاد تركيبه. يحتوي الفن التركيبي على عناصر مأخوذة من واقع الحياة العادية، ليعاد تركيبها مجددا بشكل يتخطى مفهومها الأولي.
«هذه الحركة بدأت قبل 30 عاما من القرن الماضي بعد ظهور فن الـ (بوب آرت) الذي تتمحور فلسفته حول نزول الفن إلى الشارع ليكون في خدمة الناس، وهكذا بات للكرسي تصميمات فنية متنوعة ومبتكرة. والفن التركيبي ظهر كردة فعل على سرعة العصر الاستهلاكي، إذ أدرك الفنان أنه لم يعد باستطاعة معظم الناس زيارة المعارض والاطلاع على الفنون كالسابق، بسبب ضغوطات الحياة الحديثة ولهاث الجميع في سباق مع الزمن. وهكذا سعى الفنان لتسجيل موقفه من خلال فكرة رمزية في رؤيا بصرية مركبة من عاديات حياة الإنسان، والتي تدفع الإنسان المعاصر إلى إعادة اكتشاف حياته برؤية جديدة خارج السباق مع الزمن، أي تحفيز الإنسان على التفكير بواقعه».
وقال عن حركة الفن التركيبي في العالم العربي وتناوله بين السطحية والمصداقية، «للأسف نحن العرب نأخذ ظاهر الفن فقط، علينا ألاّ ننسخ الحداثة من خلال التقليد، علينا التعامل مع الفكرة عبر واقعنا ومن ثم إنتاج عملنا التركيبي الذي سيحمل مصداقيتنا.».
ووصف تجربته في هذا المجال قائلا، «قدمت عملين في هذا الإطار وجلت بهما في العديد من مناطق وقرى لبنان. أولهما معرض استوحيت فكرته من خلال تساؤلي «ما الذي تعنيه لنا نهاية القرن العشرين؟».
وبينما كنت أقلب قلم الرصاص ذو الممحاة في يدي، أتتني الإجابة التي ترجمتها في معرض تتمحور أعماله حول «الخازوق». ومثال على ذلك العمل الذي استوحيته من أسطورة الراقصة سالومي التي لم تتردد عندما رقصت أمام الملك الذي أعجب برقصها وعرض عليها أن تطلب وتتمنى، أن تطلب رأس يوحنا المعمدان، وكان لها مرادها إذ لم يستطع رفض طلبها. وفي عملي نجد الراقصة سالومي وبيدها رأس يوحنا إلا أنها جالسة على رأس قذيفة 155 (من القذائف التي لم تنفجر في حرب لبنان)، أي أنها العدو الضحية عاجلا أم آجلا».
وعن أصداء تفاعل الناس في القرى حول هذا النوع من الفن قال، «قدمت معرضا آخر بعنوان «بيدر العالم الجديد» وطفت به في القرى وكان تفاعل الفلاحين معه كبيرا حتى من قبل الكبار في السن، إذ أن العمل التركيبي الذي قدمته مستمد من مفردات لغتهم كمزارعين، ويتمثل العمل بدائرة من القمح التي تمثل البيدر والتي كان الفلاح في السابق يجرش قمحها بالمورج وذلك من خلال وقوف رجلين على خشبة عريضة مثبت عليها حجرة مستديرة باتجاه الأرض، ليقوم بجر المورج البقر في حركة دائرية.
وفي عملي التركيبي كانت الشظايا متناثرة بين حبات القمح لأنها باتت جزء من خبزنا، واستعضت عن البقر بالبشر، وكان المورج بمثابة رجل أعمال حقيبته كمبيوتر ورأسه رأس بغل، في حين كان الفلاح تحت المورج يجرش مع القمح، أما المثقف فكان في منتصف البيدر «مخوزق» وما بيده حيلة، ثم أضاف مبتسما، «ما أثار دهشتي أنه خلال عملي على البيدر في محترفي رافقتني حمامة كانت تأتي صباح كل يوم لتبقى برفقتي زمنا».
وقال فيما يخص النصب التي أنجزها، «كلفت بإنجاز العديد من النصب والأعمال النحتية آخرها، تمثال حسن كامل الصباح، المخترع العربي الذي ولد في النبطية وعاش وتوفي في الولايات المتحدة عام 1930.
كان الصباح من أهم المخترعين في بدايات الكهرباء، فقد اخترع الطاقة الشمسية والبث التلفزيوني والحقل المغناطيسي، وله 70 اختراع أساسي. يبلغ طول التمثال المصنوع من البرونز 3، 75 مترا ويزن طن وبلغت تكلفة تنفيذه 100 ألف دولار، إلى جانب تمثال للشهيد جورج حاوي ونصب تذكاري بعنوان «تحية للمقاومة الوطنية» في ساحة كولا، وقبلها الكثير كتمثال رسام الكاريكاتور الراحل ناجي العلي، وآخر للشهيد جورج حاوي وغيرهم».
ولخص رؤيته للفن المعاصر بقوله، «بات الفن حاجة ملحة في زمن حياتنا الجافة الرقمية المتصحرة، فهو من العوامل التي تعيد للإنسان إنسانيته وعواطفه وللحب مضمونة ودفئه الإنساني بعيدا عن الرغبات والمفهوم الاستهلاكي. هذا الفراغ الداخلي، يدفع بالإنسان إلى الاهتمام بصورة أقرب إلى الهاجس في اقتناء أحدث تقنيات احتياجاته.
«تأتي هنا مهمة الفنون المشذبة أي البعيدة عن الاستهلاك، لتعيد للإنسان شعوره بكينونته ووجوده. ها هي فنون الغرب التي احتفت سابقا بالعمارات الشاهقة التي تبدو كصاروخ يشق الفضاء، تعود الآن لاستخدام الصخر والخشب والتراب والبرونز في تصميم البيوت، لمساعدة الإنسان على الإحساس بوجوده وانتمائه».
وقدم مثالا على ذلك قائلا، «أحسست بالانبهار لدى رؤيتي برج دبي وإن شعرت بنقص لشيء ما، ولكن عند البحيرة ومع رقصة النوافير على إيقاع الموسيقى اكتملت عندي الصورة. فمع صوت الموسيقى الإنساني ولعبة الماء اكتملت مشهدية قاعدة البرج برؤية نحتية ومنحته الحس الحي. الإنسان بحاجة دوما لأن يحيط نفسه بخامات من الطبيعة والمعادن النبيلة مثل البرونز والنحاس».
وقال عن واقع الفنان في العالم الثالث، «العمود الفقري لاستمرارية أي فنان ونجاحه، هو الدافع الذاتي أو الداخلي. لا شك أن الظروف المادية والاجتماعية ومصاعب الحياة تلعب دورا كبيرا، في إتاحة الفرصة للإبداع في عمر مبكر واختصار مراحل زمنية، إلا أن هذا لا يمنع في المحصلة من الاستمرار.
«مثال على ذلك السينما الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث استعان المخرجون بأناس شهدوا الحرب بدلا من الممثلين بسبب عدم توفر التمويل الكافي لإنتاج الأفلام، وكذلك الأمر في فرنسا مع ظهور الموجة الجديدة للأفلام في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، التي تعتمد على المضمون وبميزانية محدودة جدا.
«وكما نعلم تتطلب السينما ومن بعدها المسرح أضخم الميزانيات ومع ذلك وجد محبو هذا الفن وسيلة للاستمرار والإنتاج. يكفي القول أني نشأت في بيئة عائلية كانت ترفض الفنون ومنها النحت من مبدأ أنها لا تطعم خبزا، وكنت مضطرا لاستخدام زيت الزيتون في تركيب الألوان حينما كنت في الثالثة عشرة من عمري.
ويضيف، «المرحلة الوحيدة التي توقفت فيها عن النحت كان خلال فترة اجتياح لبنان عام 1978 وعام 1982 وعملت خلال تلك الفترتين في الصحافة كناقد فني. هذا العمل أفادني كثيرا على الصعيد الشخصي، فقد كان علي رؤية أكبر عدد من المعارض والتحاور ولقاء الفنانين والحوار معهم إلى جانب حاجتي لقراءة العديد من كتب الفن في التاريخ والنقد والتقنيات».
وفي الختام قال لدى سؤاله عن مقومات الناقد الفني، «على الناقد توسيع مطالعاته الفنية في التاريخ والنقد، وكمثال أذكر مجلة المعرفة في الكويت التي كانت قد أصدرت عددا كاملا عن لوحة «غورنيكا» للفنان العالمي بيكاسو، حيث ضم العدد مقالات نقدية وتحليلية وتاريخية من وجهة نظر علماء في النفس والتاريخ. كما تتطلب القراءة النقدية للنحت قراءات متخصصة، فالعمل النحتي هو نور وظل وكتلة وفراغ، وخط منحني ومنكسر وثقل وخفة وغير ذلك».
رشا المالح
 موقع هوا لبنان
موقع هوا لبنان