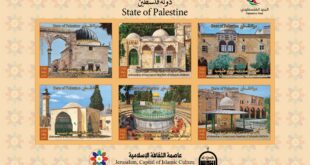كامل جابر
أقامت جمعية تقدم المرأة في النبطية والمجلس الثقافي للبنان الجنوبي، ندوة تحيّة إلى الشاعر الكبير الراحل الدكتور محمد علي شمس الدين تحت عنوان “قراءة في سيرته وشعره”، في قاعة الاحتفالات في جمعية تقدم المرأة (النبطية، كفرجوز)، حاضر فيها الأستاذ الدكتور عبد المجيد زراقط، الناقد الشاعر سلمان زين الدين، الشاعر الدكتور داوود مهنّا، وأدارها مسؤول اللجنة الثقافية في المجلس الثقافي (فرع النبطية) الأستاذ عبد المنعم عطوي، بحضور حشد من الفاعليات النسائية والأكاديمية والثقافية والتربوية والاجتماعية.

في تقديم الأستاذ عبد المنعم عطوي، قال: “حين يحتضر شاعر، تطأطئ الأشجار جميعاً أغصانها، لا تجعلها تسقط، بل تتركها معلقة كأنها أكمام خاوية، وترى الشمس لو أمكنك أن تراها، من خلال سديم، تصفها بنفسها، من المياه المالحة ورذاذ المحيط.
أما حين يموت شاعر فتعمّ البهجة في السموات والأرض، وتطلق الأشجار حفيفاً عالياً، وتسطع الشموس سطوعاً وهاجاً، وتهدر المحيطات. ذلك لأن الشاعر يسافر، يعود أخيراً إلى منبع الصوت، حيث تقيم الأشياء جميعاً إلى الأبد.. مخلفاً وراءه الجسد الذي فيه ذكرى للآلهة، الذين كانوا يشاركون السّيْر على ذلك الدرب المضيء.
عندما يموت الشاعر، يبكيه كلّ أصدقائه، كلّهم يبكونه. عندما يموت الشاعر العالم كلّه يبكي، إنّه الإنكار لفكرة الرحيل، لفكرة البوار، لفكرة الهلاك. ذلك لأن قصائده كتبت في الحقول، في مساكب الورود، في تفتّح البراعم وفي أغنيات العشّاق في الليالي المقمرة.
ربما وجود الشاعر لا يقلّل وجود المآسي، لكنه يجعل الحياة ممكنة، لأنّه يظهر لنا جماليّة الوجود باللغة. يقلّل الشاعر حجم البؤس في عالمنا حين يأخذنا إلى لغة الجمال. الإبداع لا يمكن إلا أن يكون منفذاً إلى عالم آخر، مدهش وجميل. كثيرون هم الشعراء الذين تنبأوا بموتهم، وهناك شعراء خلّدتهم قصائدهم أبد الدهر. ومحمد علي شمس الدين، واحد من هؤلاء الشعراء الكبار، ترك عشرات الدواوين الشعريّة التي تمتاز بالعمق الفلسفيّ والبعد العرفانيّ. هو في الطليعة من شعراء الحداثة في العالم العربيّ، منذ السبعينات. نشاطه الشعريّ متعدّد ومتنوّع، يتفاعل في نتاجه الإبداعي مع رموز التاريخ العربيّ والإسلاميّ. ترجمت أشعاره إلى أكثر من لغة، إلى الاسبانيّة والفرنسيّة والإنكليزيّة. كتَبَ عنه الكثير من النقاد العرب والغربيّين، ومن بينهم المستشرق الاسباني بدرو مونتابيس حيث قال: “يبدو لي أنّ محمد علي شمس الدين، هو الأسم الأكثر أهمّيّة، الأكثر وعداً. في هذا الشاعر شيء من المجازفة، شيء ما يبعث على المجرّد المطلق المتّحد الجوهر. قلّة هم الشعراء الذين ينتصرون على مغامرة التخيّل، ويتجاوزون إطار ما هو عام وعادي”.

وتحت عنوان “محمد علي شمس الدين: نصف قرن من الشعر” قال الشاعر سلمان زين الدين: (ننشرها كاملة) “ذات قصيدة، سأل الشاعر محمد علي شمس الدين صديقه الشاعر جوزف حرب، غداة رحيله: “أسئمْتَ هذا المشهدَ البدويَّ/ في مدنِ الذبيحةِ والخرابْ/ فرحلْتَ/ أم أنّ البنفسجَ لم يعدْ يكفي/ ليرتُقَ ما تفسَّخ من نسيجِ الأرضِ/ والطرقاتُ قُطّاعٌ وسيّافونَ/ قد جعلوا هواهُمْ في الخديعةِ ربَّهُمْ/ فإذا رمَوْا أو صوّبوا/ قتلوا القمرْ؟”. غير أن جوزف لم يجب لعلمه أن محمد يعرف الجواب. وأراني أطرح السؤال نفسه عليه، في هذه العشية، رغم علمي أن محمد لن يجيب، لأنني، بدوري، أعرف الجواب، ذلك أن الذي يصعّد في معراج الشعر أو يحفر في باطنه لن يسأم أبدًا.
نصف قرنٍ، راح محمد علي شمس الدين يمارس “التصعيد في معراج الشعر أو الحفر في باطنه”، على حد تعبيره، ولم يسأم. والتصعيد والحفر مفردتان مختلفتان لغويًّا في المعنى والاتجاه. غير أنهما، بالمعنى الشعري، تتضادّان في السبب وتترادفان في النتيجة، وتفضيان إلى الشعر. هذه الحركة المزدوجة التي راح الشاعر يمارسها، طيلة نصف قرن، تمخّضت عن بَرَكة كبيرة، سبع عشرة مجموعة شعرية، كرّسته قامة شعرية باسقة، ومنحته موقعًا متقدّمًا على خارطة الشعر العربي المعاصر والحديث، وجعلت الهيئات الثقافية تبادر إلى تكريمه، بين الفينة والأخرى، وهو ما أقدمت عليه الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة في مصر، على سبيل المثال لا الحصر، بإعادة طباعة ثلاث مجموعات شعرية له، في كتاب واحد، هي: “الشوكة البنفسجية”، المجموعة الرابعة. “أميرال الطيور”، المجموعة السابعة. و”منازل النرد”، المجموعة التاسعة، في سلسلة أعماله الشعرية. وبالعودة إلى تاريخ صدور المجموعات الثلاث، يتبيّن لنا أن أحد عشر عامًا تفصل بين الأولى والثانية، وأن سبعة أعوام تفصل بين الثانية والثالثة. وإذا ما اعتبرنا أن اختيار الشاعر هذه المجموعات دون سواها مسألة لا تخلو من الدلالة، فإن إلقاء الضوء عليها، باعتبارها محطات في مسيرته الشعرية، من شأنه إضاءة هذه المسيرة دون أن يعني ذلك اختصارها أو اختزالها.
لعل ما يميز شعر محمد علي شمس الدين عن سواه، سواء في هذه المجموعات أم في غيرها، هو أنه شعر صعب، ويحتاج الى قارىء مثقف لسبر أغواره. ولعل صعوبته تتأتّى عن تعدّد مرجعيّاته الثقافية التي يصدر عنها ويحيل إليها، وتتراوح بين الصوفية، والدينية، والفلسفية، والأدبية، والتاريخية… ولعل أكثرها حضورًا في شعره المرجعية الصوفية. على أن الشاعر يتقن استثمار مرجعياته وتوظيفها في النص، في نوع من التناص الخفي، الذي يغنيه ولا يثقله. وهو يفعل ذلك على طريقة القطب المخفية في نسيجه النصي. ويترتّب على استخدام المرجعيات، على أنواعها، القول إن الرؤية الشعرية لديه تصدر عن الإيمان بوحدة الوجود، القلق الوجودي، العلاقة الجدلية بين الانسان والطبيعة، واختصار المسافة بين الخالق والمخلوق، ففي واحدة من التفاتاته الجميلة يقول: “كلّ مساءٍ، أجمع حفنة ماءٍ/ أسكبها فوق يديه/ وأجلس تحت أصابعه/ أتلقّف حبّات الماء المتساقط منها” (ص 07).
هذه الرؤية الشعرية يعبّر عنها الشاعر بأشكال مختلفة، تتعدد الأنماط اللغوية فيها، وتتراوح بين السردي، والحواري، والوصفي… على أن الأول أكثرها استخدامًا، مع الاشارة الى أن السرد هو مجرّد اطار خارجي للقصيدة، وهو السلك الذي ينتظم الشعر، ويجذب المتلقي الى حقله المغناطيسي دون أن يشغله عن الاستغراق في جمال القصيدة. وكأن القصيدة عند شمس الدين هي هذا التفاعل المدروس بين خارج سردي وداخل شعري، والخارج هو مجرد اطار للصورة الشعرية التي تبقى الأساس في قصيدته. على أن النمط السردي قد يتم، بدوره، في اطار حواري بين صوتين أو أكثر داخل القصيدة الواحدة…أمّا النمط الوصفي فيتم بواسطة التصوير الشعري.
وبمعزل عن النمط اللغوي المستخدم في هذه القصيدة أو تلك، فإن شمس الدين يمتلك خيالاً مجنّحًا لا سيّما في القصائد الصوفية، وهو خيال يوغل في الغرابة أحيانًا حتى يلامس السوريالية في التعبير عن رؤيته الشعرية. يستخدم الغرابة للتعبير عن الغربة والاغتراب، وكأني به يرسم تصميمًا مسبقًا لقصيدته ثم يقوم بتنفيذه على الورق ما يجعل النص متماسكًا، مدروسًا، ولا يخضع للصدفة الشعرية. ثمة هندسة شعرية صارمة في القصيدة لا تترك مجالاً للمصادفات.
في “الشوكة البنفسجية”، ترتفع النبرة الإنشادية/ الدرامية لا سيّما في القصائد الطوال، وثمة مقاطع بعينها تتكرّر داخل القصيدة كلازمة، فتنتظم القصيدة كسلك، وتتعدد تمظهرات الأنا الشاعرة، فيتخذ شمس الدين من بعض الشخصيات، التاريخية أو المتخيّلة، أقنعة للتعبير عن هذه الأنا، دون أن يترتّب على ذلك تماهٍ حتمي بين الوجه والقناع، وبذلك، تطل الأنا الشاعرة من خلال: ديك الجن الحمصي، شهريار، قائد الجند، الذئب، المعري، السياب، رامبو، وسواها… على أن ما يجمع بين هذه التمظهرات هو اشتراكها في الغربة والاغتراب والخيبة والوحدة والوحشة…، ولعل هذا ما يفسّر مسحة الحزن التي تطغى على هذه المجموعة وسواها. وشمس الدين في استخدامه الأقنعة الشعرية لا يمارس دكتاتوريته التي يمارسها في صناعة النص بل قد يكون ديمقراطيًّا إلى أبعد الحدود، فيترك للشخصية القناع أن تقول تجربتها كما تشاء في المضمون ولكن بلغة الشاعر. وهذا ما يفعله في “عودة ديك الجن إلى الأرض”، وفي “تعب شهريار وهواجس الليلة 1000″، على سبيل المثال.
في “أميرال الطيور”، ترتفع النبرة الصوفية، وتحضر في عدد من القصائد، سواء على مستوى الفكر الصوفي أم التعبير، ولعل القصيدة الأولى في المجموعة، “ولي الريح”، هي الأكثر تعبيرًا عن هذه النبرة، حيث يتماهى الشاعر العاشق بالمعشوق ويضحّي لأجله بكل شيء، وحيث يتمظهر المعشوق بكل ما يظهر كرامته، ويبرز تأثيره في الطبيعة والفلك والعاشق والدين: “هذا أنت/ رأيتك محفوفًا بالغزلان/ ودمعك يجري/ كاياقوت على صدرك/ ورأيت على مئذنتين بهاك/ فهمت على وجهي/ وعراني الحال…” (ص 123). وفي قصيدة صوفية أخرى، “آدم لا يندم”، يطرح شمس الدين أسئلة الكينونة مستعيدًا أسطورة آدم وحواء، والخروج من الجنة، وسقوط آدم فيما حُذِّر منه، وفيها يتخطى الحضور الصوفي المستوى الفكري الى التركيبي، فنقع على تراكيب “نفّرية” (نسبة الى النفّري)، كما في قوله: “أوقفه بين يديه، وقال…” (ص 144). على أن المرجعية الصوفية، بمستوييها الفكري والتركيبي، ليست الحاضر الوحيد في المجموعة، بل ثمة عوالم غرائبية، حلمية، خرافية، طفلية، وطبيعية…، ما يعكس قوة الخيال وبكارة الصور حتى وان جرى التعبير عن هذه العوالم بتراكيب سلسة، أمينة على العلاقات النحوية بين المفردات، ففرادة النص تقوم على العالم المتخيَّل أكثر ممّا تقوم على التراكيب ومفرداتها…، وفي الشكل، لم يخرج شمس الدين عمّا اعتمده في “الشوكة البنفسجية”، من سردية الاطار، وتعدد الأصوات، واصطناع الأقنعة…
في “منازل النرد”، تترسّخ، أكثر فأكثر، المرجعية الصوفية، وتحضر الى جانبها، ومن خلالها، غربة الأنا الشاعرة ووحدتها، التاريخ مدنًا وشخصيات، جدلية الأرضي والسماوي، والواقع الثقيل في العراق ولبنان…، وتتعدّد المرايا التي تعكس صورة الشاعر، سواء التاريخية أم المتخيّلة، من قبيل: صالح، الامام علي، سالم المجنون، حسن كامل الصبّاح، الحلاج، المعري، أبي حيّان التوحيدي، ابن خلدون، وغيرها…
والشاعر، في التعاطي مع هذه الشخصيات، يترجّح بين تقنيتي المرآة والقناع، ويقوم باسقاط بعض ملامحه على هذه الشخصية أو تلك، فتغدو الشخصية، سواء أكانت قناعًا أم مرآةً، صنيعة الشاعر بقدر ما هي صناعة التاريخ إن لم يكن أكثر. وهنا، تتحوّل العملية الشعرية إلى حوار مع الماضي، انطلاقًا من الحاضر، واستشرافًا للمستقبل.
إن مساءلة الماضي، ومعاينة الحاضر، واستشراف المستقبل، عند محمد علي شمس الدين، إنما تتم بالشعر، فالشعر هو خشبة الخلاص من وحول الماضي، ورمال الحاضر المتحركة، وصولاً إلى برّ أمان، حتى وإن كان فرديًّا وليس جماعيًّا، وهو ما مارسه الشاعر طيلة نصف قرن.
وبعد، لا بدّ من الإشارة، في ختام هذه العجالة، إلى أن ستة عشر رسمًا، بالأبيض والأسود، تزين “أميرال الطيور”، وثلاثة عشر رسمًا تزين “منازل النرد”، رسمها الفنان حسن جوني، فتدخل الرسوم في علاقة تفاعلية/ تكاملية مع القصائد، وتتوّج لقاء قمّتين، شعرية وتشكيلية، على صفحات الكتاب، وبين الشاعر والرسام توأمة نادرة تقوم على النسب الإبداعي، والقلق الوجودي، والنظرة المشتركة إلى الوجود، حتى وإن اختلفا في وسيلة التعبير. وينجم عن هذا التجاور/ التفاعل/ التكامل بين الشعر والرسم أن تضيق المسافة بين النوعين إلى حد نتساءل معه: هل نحن إزاء قصائد مرسومة بالأسود والأبيض أم نحن إزاء رسوم ملوّنة بالكلمات؟”.

واستعرض الشاعر داوود مهنا محطات من حياة الشاعر، من مولده في قرية بيت ياحون في قضاء بنت جبيل، ومدرسته الأولى، إلى انتقاله مع والده إلى العاصمة بيروت والتدرج في التعليم، الثانوي فدار المعلمين والمعلمات ثم الجامعة والدراسات الجامعية، وقصائده المحاولات والتي لم تنشر، إلى قصائده الأولى في مراحل الشعر المتصاعد.

بعدها كانت محاضرة الأستاذ الدكتور عبد المجيد زراقط، والتي جاء منها: “غيَّب الموت الشاعر الكبير والصديق العزيز محمد علي شمس الدين. للموت حضور في شعر أبي عليٍّ ونثره. في كتاب: “حلقات العزلة”، كتابه الممتع والمؤنس والمضيء، طرح هذا السؤال الوجودي والأزلي: “ماذا يفعل الانسان في مواجهة مقبرة كبيرة هي التاريخ يرفرف فوقها علم بشكل غراب اسمه الموت؟”.
في هذه القراءة، التي تحتملها مقالة قصيرة، في سيرته وشعره نحاول أن نتعرف اليه والى شعره، وأن نتبيَّن الاجابة عن هذا السؤال.
محمد علي شمس الدين ( ١٩٤٢ – ١١/٩/٢٠٢٢) شاعر لبناني كبير، وناقد نافذ الرؤية، وباحث وناشط ثقافي. ولد في قرية “بيت ياحون “. يقيم في بيروت، ويعود الى قرية “عربصاليم”، بين وقتٍ واَخر.
ينتمي الى أسرة دينية وشعرية، تقتني مكتبة مملوأة بكتب التراث، وتُعقد في بيوتها مجالس أدبية يُقرأ فيها الشعر، ويُنقد، وتدور أحاديث السمر مع كؤوس الشاي.
تلقَّى العلم، في المرحلتين: الابتدائية والمتوسطة، في قريته “بيت ياحون”، والثانوية في المدرسة النموذجية الثانوية، فرن الشباك. نال اجازة في الأدب العربي، واجازة في التاريخ، وماجستير في التاريخ، موضوع البحث فيها “الاصلاح الهادئ عند العلامة المصلح السيد محسن الأمين”، عام ١٩٨١، ودكتوراه دولة، في التاريخ، عام ١٩٧٧، موضوع البحث فيها “الحدث التاريخي، في عصر بني أمية”.
درَّس تاريخ الفن في معهد التعليم العالي، وعمل مفتشاً في مؤسسة الضمان الصحي والاجتماعي اللبنانية، وترقَّى الى أن تولَّى منصب مدير التفتيش، في هذه المؤسسة، قبل أن يتقاعد في عام ٢٠٠٦.
قرأ لأبي العلاء المعري أوَّل ماقرأ، وقلَّده بأشعار نظمها، وهو في الثانية عشرة من عمره. أولى قصائده التي نُشرت قصيدة “ارتعاشات اللحظة الأخيرة”، نشرت عام ١٩٧٣.
أبدى نشاطاً ملحوظاً في عضوية عدد من المؤسسات الثقافية، وشارك في الكثير من المؤتمرات والملتقيات الشعرية والنقدية والفكرية، في لبنان والوطن العربي، وبعض العواصم العالمية.
تُرجم معظم شعره الى الأسبانية ولغات عالمية أخرى. له مجموعات شعرية كثيرة، جُمعت في أعمال كاملة، وقصص وشعر للأطفال ودراسات ومقالات أدبية.
نال جائزة العويس، دورة ٢٠١٠- ٢٠١١، وجائزة الشارقة للشعر العربي عام ٢٠١٥.
محمد علي شمس الدين انسان دمث، لطيف المعشر، ودود ومتواضع، صلب يتشبَّث بكل موقف يعتقد بصوابه…
يقدِّم محمد علي شمس الدين نفسه لقرائه، ومما يقوله، في هذا الشأن: “في مكان مفتوح للشمس والغبار ومساحات التبغ الشاسعة الصفراء، كنت الولد البكر لأبويّ، وأنا ابن الماَذن الجنوبية والأجراس والتراب والحجارة والصخور…. ثم جرَّني المتنبي من يدي وأبو العلاء المعري وبدر شاكر السياب ورامبو وأنطونيو وماشادو وديك الجن الحمصي…. في تاريخنا تجارب غنية، نحن مصدر النبوَّة والشعر في التاريخ الانساني…”.
يفيد هذا التقديم للذات أنَّ تجربته الشعرية التي تملي نصَّه الشعري الخاص الجديد تتكوَّن من التراثين العربي والانساني، ومن عيش الحياة اليومية، فيجدِّد وهو متصل بالعيش: ماضيه وحاضره، ورؤى مستقبله.
وهذا ماتفيده قراءة شعره، فهو، كما تفيد هذه القراءة، شاعر حديث يتصل، من نحوٍ أول، بالتراث العربي/ جذر الأنا، وبالإنجاز الغربي الوافد/ انجاز الاَخر، ويصدر عن هذين المكوِّنين، وعن الحياة/ الوجد بها، أي يتصل بالأنا حاضراً وماضياً وبالاَخر، وينفصل، من نحوٍ ثانٍ، فيصدر عن هذا كله، من دون أن يكونه، بمعنى أن يكون شعره ولادة الجديد كأيِّ ولادة حقيقية تصدر عن والدين، ولا تكون ايَّاهما.
وجدُه بالحياة هو وجدٌ بمرارات العيش، وخصوصاً مرارات الهم الجنوبي المتمثلة بقوله: “فلتفتح، يااَذار، شبابيك التيه/ لي طفل يبحث عن لعبته في قبر أبيه”، فكم من شبابيك تيه فُتحت، وتُفتح في وطننا العربي الكبير، وكم من أطفال يبحثون عن لعبهم في قبور أمهاتهم واَبائهم، وكم من رجال ونساء يبحثون عن لقمة العيش في كلِّ مكان فلا يجدونها، بل يجدون الأدهى من المرارات التي تطلع بها شمس كل يوم، في هذا الليل الاَتي في كل نهار.
يصدر، في شعره، بدءاً بهذه المرارات، ووصولاً الى المقاومة، الى قمر الجنوب، المتمثل في قوله: “قمر الجنوب الذي استدار، وصار يحوم حول الشمس المرَّة، ويحرق أشواك حمالة الحطب”. هذا النسيج الشعري المتشكل من رموز طبيعية وتاريخية اسلامية يرسم صورة شعرية للمقاومة كاشفة، فهي تُجدِّد، في هذا العصر، مقاومة “حمالة الحطب“ التي لاتنفك تتجدَّد في كل حين من الزمن، وهي، أي “حمالة الحطب”، في زمننا هذا، تحمل أشواكها/ مستوطنيها وترميهم في بلادنا، ويكون على القمر الذي يستدير جنوباً أن يضيء دروب سالكي طريق الحق وان قل سالكوها، من دون أن يستوحشوا، عملاً بقول امام المتقين.
تتسع هذه المعاناة لتصبح معاناة انسانية، فيكون الجنوب اللبناني رمزاً لمعاناة المقهورين/ المقاومين في كل جنوبٍ في العالم….
عبَّر شمس الدين عن هذه المعاناة الانسانية في شعره، وفي نثره، ففي كتاب “الطواف”، وهو سيرة شخصية وشعرية، كانت هذه المعاناة طوافاً ذا قدسية، يرقى الى مستوى العبادة، وينطق برؤية تنتمي الى “أيوب الصبر والرجاء”، وليس الى “سيزيف العبث والخواء”، وهي لهذا تتيح للرمادي أن يتجلى أفقاً أخضر، اذا واصل طوافه، وحقق انجازه، وتتيح لـ”نرجسة النار”، والشاعر يرى، في قصيدة “ميم يحرث في الاَبار، أنه هو هذه النرجسة، أن تتوهج زهراً وعبقاً، ولا تموت، وهي في قلب اشتعال اللهب، فيتلوَّن شعره بنغمة حزن عميق لاتخفى، هو حزن الشجن العربي التاريخي، وحزن التعب الرائي الى بوح نرجسة النار، فيكون الرائي مثل جبل “الريحان“ الذي “كانت أطراف عمامته تتخافق مثل مسيح الريح، وتحملها عنقاء النهر الى الوادي”.
هوذا حزننا على فقدك، أيها الرائي والكاشف الكبير، وان كان الموت قاهراً، فالشعر، وهو “جنون القلب”، يتدخل ضد الموت، ويكون معراج الخلود، في فعل يواجه عبث الحياة المتوَّج بالموت. هذه هي اجابتك عن السؤال الوجودي الأزلي، تمثلت في ابداعك الذي لا يموت، وان مات قائله، كما قال دعبل الخزاعي في قديم الزمان.
تتمثل هذه الرؤية في شعر غنيٍّ بالصور والرموز والأقنعة والأسئلة الفلسفية والوجودية. هذا هو الشعر الحقيقي، كما رأى المستشرق الأسباني “ماتينيز فيتانيز“، عندما قال: “ان شعر محمد علي شمس الدين يعدُّ “المثال الواضح لما هو جوهري للشعر الحقيقي: ايقاع الاتصال والتجديد”.























 موقع هوا لبنان
موقع هوا لبنان