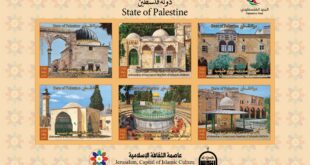كامل جابر
كان يمكن علي حسين رامز ياسين أن يسجّل رقماً قياسياً في مهنة التجارة التي بدأها فتى في مطلع السبعينيات وشهرته الواسعة، لولا مداهمة جائحة “كورونا” واستحكامها برئتيه بالرغم من تلقّيه اللقاح بجرعتيه، الأولى والثانية..
كنا في مطلع العمر عندما بدأ اسم “علي ياسين” يتردد على ألسنة تلامذة ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات في النبطية، ممن يزورون حانوته المتواضع، عند أسفل المدرسة (ثلاثة أمتار بأربعة أمتار) قبل بدء دوام التدريس أو في الفرص المتفاوتة حاملاً إليهم صندوقة المناقيش أو بعض الحلوى المعروفة والمحدودة في ذاك الوقت. وسرعان ما شاع اسم علي ياسين إلى الجوار، في حي “خلّة الهوا” وامتداداً نحو أحياء النبطية، ثم إلى القرى المجاورة التي كان يأتي منها تلامذة المدرسة “الجارة”.
في سنين قليلة انتشر اسم علي ياسين كالنار في الهشيم، إذ كان حانوته يتسع وبالرغم من صغره “ربما” لكل أنواع البضائع التي تحتاجها ربّات البيوت والأطفال، من مواسم العيد إلى مواسم الصيف والربيع، إلى أنواع التبغ وكل جديد يداهم السوق المحلية التي بدأت تحاصرها قذائف العدو الإسرائيلي واعتداءاته منذ أواسط السبعينات، فتقفل متاجر المدينة ومحلاتها، ويبقى متجر علي ياسين مفتوحاً بالرغم من فداحة هذه الاعتداءات.
لم يكن علي ياسين مجرد بائع عادي، فقد نمت بينه وبين تلامذة المدارس وذويهم وزبائنه علاقة ثقة ومحبّة، إذ كانت بضائعه على سبيل المثال، تصل إلى الباصات والسيارات التي تقل التلامذة كي لا يدركهم الوقت صباحاً، من دون فطور، ويقوم هو بنفسه، في تأدية هذه الطقوس الخدماتية، ناهيك عن أنه كان يحفظ اسماء التلامذة والزبائن بسرعة فائقة، وكَرَمِه المعروف تجاههم، خصوصاً بعد اتساع تجارته وانتقاله إلى محل مجاور أوسع بكثير من السابق (الذي لم يغادره برغم هذا الاتساع احتراماً لذاكرته وبداياته التي لم ينكرها يوماً)، وصارت “ميني ماركت ياسين” مقصد الآلاف من أبناء النبطية والجوار، وعنواناً من العناوين الثابتة في عاصمة القضاء ثم المحافظة.
لم ينل تاجر أو “حانوتي” في النبطية والجوار شهرة مثل شهرة علي ياسين، إذ أضحى من أسماء النبطية الحُسنى في سمعته التجارية وفي اتساع علاقاته ومعارفه إلى حيز يتجاوز عشرات الكيلومترات من النبطية، فضلاً عن أن الأجيال التي تعاقبت على ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات في النبطية كانت تحمل معها بعد تخرّجها ومغادرتها نحو الجامعات وغيرها، الحنين وطيب العلاقة مع صاحب المتجر المجاور، مع علي ياسين، والكلام هنا عن عشرات الآلاف..
مات علي ياسين بعد سنوات قليلة من بلوغه الستين، وماتت معه قصص من ذاكرة النبطية وحكاية رجل عصاميّ صعد السّلّم درجة درجة، مذ كان هذا السلّم من خشب الأشجار القروية قبل أن ينتظم بألواح خشبية متقنة. لكن تبقى في النبطية سيرة عائلة طيّبة اتّسعت مداركها التجارية وعلاقاتها وانتشرت في المدينة وضواحيها على أكثر من مستوى بفضل ما بدأه علي ياسين ووالد علي “حسين رامز” وأشقاؤه وأعمامه.
تبدّى الوفاء والحب اليوم، في مواراة علي ياسين التي شارك فيها المئات من مختلف المشارب والأعمار، ومنهم التلامذة ممن أضحوا أرباب عائلات وذوي تلامذة، وربّما لولا جائحة “كورونا” التي اختطفت علي ياسين لشاركت الآلاف في تشييعه، ما يدلّ على مدى الحب الذي زرعه علي مع الطيبة والثقة والعلاقة الممهورة بابتسامته الدائمة… مشاركة اتسمت بالحزن الواسع والفقدان.
يعلق أحد التلامذة على “فايسبوك” كاتباً: “اليوم ولأول مرّة من أكثر من ثلاثين عاماً يقفل علي ياسين متجره”. هو الموت المحتّم الذي اختطف منّا العديد من الأصدقاء والأحباب في مدة وجيزة، وذاكرة النبطية العامرة بالأسماء الجميلة ستبقى تحفظ اسم علي ياسين وحكايته وتجارته من جيل إلى جيل، قصّة العزيمة التي بدأت في روح فتى غادر المدرسة ليكون تاجراً وصبر وصبر حتى أضحى معلماً من معالم المدينة الإنسانية والأخلاقية والتجارية البعيدة عن الاستغلال والاقتناص.
وداعاً علي ياسين…
 موقع هوا لبنان
موقع هوا لبنان