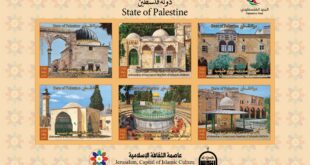سيرة مقاوِمة ذكّرتنا أن لا فن بدون كرامة

لطالما رددت أن الصوت سلاحها، عثرت عليه في عام 1982 أثناء اجتياح بيروت وخروج المقاومة الفلسطينية منها. بنت الناصرة كانت وقتها في الـ 16 من عمرها، لكن القصة بدأت قبل ذلك بكثير. ولدت في 1966 عام الكذبة الكبيرة التي ادعت فيه دولة الاحتلال إعطاء الحقوق للفلسطينيين المتبقين في أراضي الـ48. فتحت الطفلة الصغيرة عينيها على النكسة والهزيمة العربية 1967. تكرج بها الأعوام الأولى في «مدينة البشارة» بعنصرية ومصادرة أملاك وقوانين احتلال صارمة لكل فلسطيني، وبوجوه ولغات كثيرة لمستوطنين يزدادون يوماً بعد يوم لالتهام كل ما يحيط بها. في منتصف الثمانينيات ومع اشتداد موجة الهجرات الصهيونية إلى الأراضي المحتلة، ستغادر مدينتها إلى موسكو لدراسة الموسيقى.
ستطلق أول صوت مدوٍّ، ألبوم «جفرا» (1985) وبعدها بعام «دموعك أمي» تهديه لأمها وملهمتها الشاعرة والمناضلة زهيرة صباغ.
في 1993 واتفاقية «أوسلو» المشؤومة، وفي عز حملة غسل الأدمغة وبيع الأوهام، سيأتي ألبوم «الحلم» بوعي الفنانة المبكر، تنبه وتذكر بكلمات سميح القاسم «احكي للعالم احكي له/ عن بيت كسروا قنديله.. لماذا صارت أيدينا بحبال اللعنة مجدولة».
من موسكو ستعود إلى فلسطين عامرة بالحب والحياة. ستعيش طفولتها مجدداً، توجه صوتها وجوارحها لأطفال فلسطين بـ «قمر أبو ليلة» (1995) و«مكاغاة» (1996). ستندلع الانتفاضة الفلسطينية، ومن رحمها سيخرج ألبوم «وحدها بتبقى القدس» (2001). في تلك المرحلة التي شهدت واحدة من أكبر حملات اعتقال في التاريخ الفلسطيني لعشرات الآلاف من الشبان والشابات المنتفضين؛ سيظهر ألبوم «مرايا الروح» (2005) الذي ستكرسه للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال. شكل العمل نقلة نوعية في مسيرتها؛ وسمح لها بتكوين جمهور واسع في العالم العربي. بعدها بعام وتزامناً مع «عدوان تموز»، يصدر لها «لم تكن تلك حكايتي» لتهديه إلى الشعبين اللبناني والفلسطيني، تسلّم به على أحبابها في لبنان وتحتفي بالانتصار: «طير يا هوى/ سلم على الحباب/ أسرع يا هوى من الطير/ إركب على ريحك وانزل تلا لبحار../ تاري هوى التيار جايب معاه اخبار تحت الجرح شايل فرح». تتبعه بـ «مواسم البنفسج» (2007)، و بـ «نوار نيسان» (2009). ستندلع الثورات العربية التي ستجد فيها أملاً في تحرر الشعوب العربية الذي يصب في تحرير بلدها، قبل أن تصاب بخيبة أمل كبيرة. سيظهر ألبومها الأخير «تجليات الحب والثورة» (٢٠١٣)، ستغني فيه كلمات راشد حسين «الله أصبح لاجئاً يا سيدي» وكلمات عمارة عمراني في جنازة المناضل التونسي شكري بلعيد «الحُر ما بين الأنذال مخنوق يُصعب صياحو». ستغني كلمات بدر شاكر السياب «غريب على الخليج» وتصدح «واحسرتاه.. يا عراق»، وستنأى بروحها مع شعراء الصوفية ابن الفارض والحلاج وابن عربي.
أكثر من ثلاثة عقود من الموسيقى والمقاومة، أرَّخت فيها الفنانة سيرتنا الذاتية، وأعطتنا درساً لا ينسى عن العلاقة العضوية بين الفنان وأرضه ومحيطه السياسي والجغرافي. في عالم الخذلان والأقنعة والنفاق والتطبيع والبيع والشراء؛ ظلت حرة مقاومة أبية، قاومت الاحتلال حتى آخر نفس، في الميادين والشوارع وعلى خشبات المسارح. هي أم الموسيقى الفلسطينية الحديثة، واحدة من أول الفنانين أو ربما أولهم في إدخال الأصوات الجديدة إلى الموسيقى الفلسطينية. ظلت تتنقل بجرأة وخفة بين الروك والبوب والبلوز والفيوجن، تصهر التهاليل الفلسطينية مع موسيقى العالم وتقدم التراث في أصوات عصرية، ولا تتردد في تطويع المؤثرات الإلكترونية والإيقاعات الجديدة.
بجانب معركتها الطويلة مع الاحتلال، دخلت عام 2009 في معركة جديدة مع سرطان الثدي. وبدلاً من أن تستكين، شهدت في تلك الفترة نشاطاً كبيراً وعروضاً كثيرة، فكانت بجسارتها مصدر إلهام كبير لملايين المصابين بهذا المرض في العالم، وكانت تقسم وقتها بين العلاج والغناء. ظلت تصدح بصوتها حتى 2016 الذي سيشكل ضربة قاسية لها، إذ ستفقد صوتها، سلاحها الأول ومصدر فنها ورزقها، جراء شلل في أحد أوتارها الصوتية. الفنانة التي كرست حياتها لفلسطين والمقاومة والحرية، ستدخل في أزمة مالية، لن تطلب مساعدة أو صدقة، بل ستتجه إلى التطريز كي تعيش.
صهرت التهاليل وقدمت التراث بأصوات عصرية
في كل مرة كان يشتد عليها المرض وتدخل المستشفى، كانت تطل علينا من صفحتها الفايسبوكية تطمئننا وتختم رسالتها بـ «سمايلي»، وتعود بعدها كمنتصرة إلى شرفة منزلها المطلة على «مرج ابن عامر». في زيارتها الأخيرة إلى المستشفى، كتب شقيقها فراس على صفحته يطمئننا، وأحسسنا وقتها أن ريم لن تكتب لنا مجدداً. مكللة بالعز والفخر محمولة على أكتاف أبناء الناصرة، حُمل نعشها أول من أمس في شوارع عاصمة الجليل المحتل، وأصوات الآلاف خلفها تصدح بـ «موطني».
لسخرية التاريخ، ولدت في العام الذي وضعت فيه الآلة الاستعمارية الإسرائيلية خطتها لاستخدام الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي التي احتلتها عام 1948: الجنسية «العربية الإسرائيلية». استُدعي الفلسطينيون للمشاركة في إضافات «عربية» في الدعاية الصهيونية الخادعة للديمقراطية الجديدة للدولة الاستعمارية. ستقضي ريم طوال حياتها تنكر وتحارب هذه الكذبة الاستعمارية: لم تكن ولن تصبح أبداً «عربية إسرائيلية» بل فلسطينية تعيش في فلسطين المحتلة.
«احرقوا جسدي بعد مماتي، وعبّئوا رفاتي في زجاجة عَرَقٍ نصراويّ، واحشوها بالبنزين لتتحول الى مولوتوف في يد مُقاوم يرجم بها أعداء الحبّ وطُغاة الأرض». هذه كانت كلماتها في وقت اشتد عليها المرض. هي التي ستبقى علامة ورمزاً في التاريخ والفن الفلسطيني، تذكرنا أن لا فن بدون كرامة، ولا كرامة بدون مقاومة.
الرؤية الأخيرة
قبل رحيلها، كتبت ريم بنا على صفحتها في 5 آذار (مارس): «بالأمس، كنت أحاول تخفيف وطأة هذه المعاناة القاسية على أولادي، فكان علي أن أخترع سيناريو. فقلت: لا تخافوا. هذا الجسد كقميص رثّ لا يدوم. حين أخلعه، سأهرب خلسة من بين الورد المسجّى في الصندوق، وأترك الجنازة و«خراريف العزاء» عن الطبخ وأوجاع المفاصل والزكام… مراقبة الأخريات الداخلات.. والروائح المحتقنة… وسأجري كغزالة إلى بيتي… سأطهو وجبة عشاء طيبة… سأرتب البيت وأشعل الشموع… وانتظر عودتكم في الشرفة كالعادة… أجلس مع فنجان الميرمية.. أرقب مرج ابن عامر.. وأقول: هذه الحياة جميلة… والموت كالتاريخ… فصل مزيّف».
حفرت أنفاق الذاكرة… وكانت مرايا الروح

علينا الاعتراف بأن العدو الإسرائيلي أشدّ وعياً منّا حول أهمية التراث والثقافة الشعبية. علينا أن نفهم سبب استماتته لضمّ ما يناسب (وطمس ما لا يخدم) مشروعه من تركة أجدادنا، من موسيقى وأزياء وحتى أطباق، بهدف «تكوين» تاريخ يفتقده، ثم تزويره للترويج له مع مفعول رجعي. الثقافة الشعبية مرآة جذور المجتمعات. والإسرائيلي يريد سرقة مرايا أرواحنا، أملاً بأن يرى العالم فيها جذوره في فلسطين. علينا ألّا نهمل هذا الموضوع ولو لثانية. لأن عندها، وعندها فقط، ندرك أهمية ما أنجزته ريم بنّا، وبالتالي حجم خسارتها وهي في عزّ عطائها.
ايهاب بسيسو: في سماء الوطن
نعى وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية الشاعر ايهاب بسيسو الراحلة ريم بنا وقال على صفحته على فايسبوك: «لن أقول عن ريم بنا… رحلت. لكنني سأقول إن هذه الأخت الفلسطينية الغالية اختارت أن تحلق فجر هذا اليوم مع الملائكة في سماء الوطن… صعدت ريم بنا نحو الأبدية وهزمت سرير المرض… وبقيت لنا الذاكرة… وبقي الصوت يغني فلسطين، وسيظل يغني فينا فلسطين رغم رحيل الجسد».
أسوأ وأخطر ما في الخبر، لمن يرى الأمور بشموليتها، هو تزامنه مع الحديث عن تسجيل الجمهور العربي إعجابه بأغنية المغنية الإسرائيلية المؤهلة للفوز بـ «أوروفيزيون» لعام 2018 (مايو المقبل)… والسوء هنا، غير ناتج بالدرجة الأولى عن مدّ إسرائيلية بإعجابٍ بعمل من توقيعها، بل، أولاً والأهم، عن الإعجاب بالقبح: أولاً، بتجرّد، قبح المغنية شكلاً، فهي تصلح نموذجاً إن أردنا تسجيد الشرّ للأطفال في الرسوم المتحرّكة (مقابل خسارة فنانة سخّرت نصف طاقتها للأطفال). ثانياً، قبح الأغنية فنياً وعدم ارتباطها لغةً (إنكليزية) ونمطاً (الغربي الهابط) بالحد الأدنى من مكوّنات فنوننا السمعية (مقابل خسارة فنانة سخّرت النصف الآخر من طاقتها لتوثيق إرث شعبها الفولكلوري). نعم، رحيل ريم بنّا خسارة. لكن، عندما خسرت «أوركسترا برلين الفلهارمونية» قائدها العظيم فيلهلم فورتفانغلر عام 1954، وصل إلى غرفة هربرت فون كارايان (قائدها التالي الأعظم) الفاكس التالي: مات الملك، عاش الملك. هكذا تتصرّف الشعوب الأصيلة. هكذا ترّد على ضربة الموت بضربة أكبر. أما نحن، وبقليل من المبالغة والخيال، فكأننا أرسلنا فاكساً لـ «أوروفيزيون» يقول: ماتت الجميلة، عاش القبح.
إذاً، بعد صراع شرس وطويل مع المرض، خسرت ريم بنّا المعركة. ابنة الناصرة أسلمت الروح حيث ولدت عام 1966. وبين والولادة والرحيل، نضال حقيقي، ذكي، هادِف، متقَن وصادق. منذ منتصف الثمانينيات، أدركت ريم أن لا مفرّ من الكفاح: إمّا لاستعادة المسروق في الجغرافيا، أو للحفاظ على ما يسعى العدو لسرقته في التاريخ. كصبية ذات ميول فنية وصوت جميل، اختارت الجبهة الثانية ومارست كفاحها بدون مواربة أو ضبابية: أغنياتنا لنا وأغنيات أطفالنا لنا. فهي طالعة من صميم حناجر الأجداد في الحقول ومن فائض عطف الجدّات على الأحفاد. نغنّيها كي لا ننساها. نسجّلها كي لا تنساها أجيالنا القادمة. نسجّل حقوقها لنحفظها من التزوير. نجول فيها حول العالم وننشدها في الحفلات ونرفع علم فلسطين، لا لشيء إلا لكي نرشد الناس إلى هويّتها. أما لناحية القالب الفنّي، ومهما انتقد من لا يستهويه الروك والبوب الغربي المعاصر، فكانت ريم أحذق من أن تتشبّث بالفولكلور: النص هو هو، اللحن هو هو (أو مع بعض التصرّف لضرورات التعبير). أما الغلاف الخارجي فعليه أن يحمل فلسطين وتراثها إلى العالم… فالمزمار والمجوز والربابة غير قادرة على ذلك. وهذا القالب، العصري غير الهابط بالمناسبة، أتقنته بمهنية. فتنفيذ أعمالها، الأخيرة بالأخص، يضاهي أفضل الأعمال الغربية في فئتها. أما حبة الكرز على قالب التنفيذ، فكان صوتها، أو الأصح أداؤها ومخارج حروفها ولكنتها التي لم تميّعها ولم «تغرّبها».
سجّلت تراثنا للأجيالنا القادمة ولحفظه من التزوير
فحتى غناؤها بالفصحى أتى دوماً فلسطينياً. هذا من جهة. من جهة ثانية، كان لريم همٌّ آخر. لنسمّه همّ الحاضر للمستقبل، إذا سمّينا عملها على التراث همّ الماضي للمستقبل. إلى جانب الاستعادات الفلكلورية (من تهاليل وأغاني أطفال وتهاويد)، رصدت آلام شعبها، ووثّقت جرائم الاحتلال بشكل مباشر. بعض أغنياتها ــ «ساره» مثلاً ـــ أقرب إلى خبر في جريدة، بكل تفاصيله، مضافة إليه اللمسة الشعرية (شعراء فلسطينيون وعرب، أبرزهم والدتها الشاعرة زهيرة صباغ) وبعض النغم والتلوين (من صنعها، بالاشتراك مع ملحنين وموزعين، على رأسهم زوجها السابق، الأوكراني ليونيد ألكسيينكو). كل هذا كان بالتأكيد يقلق العدو. فأحياناً لا ندرك أهمية الأغنية، لكن ذلك لا يمنعها من حفر أنفاقٍ للذاكرة بثبات.
نقلت ريم بنّا ماضي وحاضر شعبها إلى العالم، لكنها تأخرت لتشاركه مع جيرانها الأحب إلى قلبها في سوريا ولبنان وحتى في فلسطين (غنّت افتراضياً عبر سكايب من بيتها في الناصرة في دمشق وبيروت وغزة المحاصرة). فكونها من الأراضي المحتلة عام 1948، لا يُسمح لها بالدخول إلى هذه البقع القريبة إلا بعد إجراءات شديدة التعقيد. زارت لبنان أول مرّة عام 2010، لكنها لم تغنِّ. ثم عادت عام 2012 وأحيت أمسية في بيروت. بيروت حلم معظم الفنانين الفلسطينيين، ومتى زاروها يسألون غالباً عن زياد الرحباني. التقت ريم بزياد عندما عادت مرةً أخيرة إلى بيروت عام 2014، وغنّت رائعته الجديدة «صمدوا وغلبوا» واثنتين من أغنياتها برفقته ضمن حفلة له في «المركز الثقافي الروسي». في المرة الأولى، طلبت اللقاء به، لكن التواصل معه كان غير ممكن في تلك الفترة. هكذا، توجهّت إلى Notta Studio وتركت له بعضاً من أغانيها وتذكارات حملتها من فلسطين المحتلة، من بينها حفنة من ذاك التراب الذي تعود إليه اليوم… غزالةً بيضاء صغيرة.
الأغاني في فمّكِ ياسمين

الرسالة الصوتية الأخيرة التي وصلتني من ريم كانت قبل شهر ونيف، تخبرني فيها بعض تفاصيل عملها الجديد المختلف الذي تسجله في النروج وحوّلت فيه «الفحوصات المخبرية» إلى نوتات موسيقية و«أغنيات» غير مسبوقة. أما رسالتي الأخيرة لها، فكانت قبل أيام وفيها صلاة ودعاء لنهوضها مجدداً كما عودتنا دائماً، أن تغلب المرض وتنتصر للحياة، أن تعود لمقاومة خبيثين هما المحتل الإسرائيلي والسرطان، فضلاً عن مقاومتها «الظروف» الخاصة والعامة، لتواصل نشر الحُبّ والجمال صوتاً وصورةً، أو كتابة… وتطريزاً حين خان الصوت صاحبته.
للأسف هذه المرة كان الخائن الجسد كله، الجسد الذي ناء بروح لا تهوى غير التحليق ولا تجيد إلَّا الطيران. لكن حتى هذا الجسد الذي سُجي بين الورود ثم ووريَ في الثرى، ما استطاع كتم صوت أيقونة فلسطين (تماماً كما وعدت أبناءها في نصها الأخير المؤثر)، لأن روحها عائدة في ألبومها الجديد المقبل صوتاً يهتف للمقاومة والحرية والرفض والتمرد.
لدي الكثير لأكتبه عن ريم ولها، هي التي حققت حلم زيارة بيروت لأول مرة بدعوة من برنامج «خليك بالبيت» وودعتَها بزيارة أخيرة إلى «بيت القصيد»، وبين الزيارتين سنوات ثمان وسمان من الصداقة والمودة، من الأمسيات المشتركة والحوارات والرسائل والكلمات المزهرة تماماً كالورود على شرفتها الناصرية. لكن الآن هو وقت الدمع لا الحبر، وقت الحزن لا الرثاء. يكفيني منها في لحظة الأسى واللوعة أن صوتها متغلغل في الروح والوجدان وصورتها مقيمة في القلب والذاكرة.
يوم لقائنا الأول قبل ثماني سنوات، كتبتُ أنها تصارع خبيثيْن الاحتلال والسرطان، ومن ذاك النصّ أستعيد منه:
هذه البلاد نحفظها غيباً كالصلاة
هذه الجبال تعرفنا كأثداء الأمهات
نحن هنا، أنتِ هنا
ثوبُكِ الجليليُّ مُشَنْشَلٌ بالموسيقى،
في مِعْصَمَيكِ فِضَّةُ التعب
على جبينكِ هبوبُ الريح
الترابُ في كفّيكِ قمحٌ
والأغاني في فمكِ ياسمين
لا الرصاصة تقتل فكرة
ولا السياف قادرٌ على جزِّ عشب الشهداء.
غداً ينبت العشب والزهر فوق ضريح ريم، أما في وعينا ووجداننا فينبت صوتها منتصراً للمقاومة والحرية، مبشراً بأن ورد فلسطين، لا محال، سوف يكسر سيف الاحتلال.
حكاية عشق طويلة مع تونس

تونس | انهالت رسائل النعي والتعازي الصباحية، وبات الأمر حقيقة لا مفر منها: رحلت ريم بنا فجراً. كثيرة هي الصداقات التي أزهرت بين رفاق ريم على مختلف جنسياتهم، وامتزجت الدموع بذكريات السنوات الأخيرة. وفي استحضار ذكرى ريم، استحضار لذاكرة الأماكن، وأوّلها ـــ بعد فلسطين ــ تونس. ليس هذا لأسباب وطنية شخصية، من بينها أن في تونس كان لقاؤنا الأول، بل لما كانت تكنّه ريم من حب لبلاد علّقت خريطتها الفضّية بعنقها، إلى جوار خريطة فلسطين، واخترعت لأهلها كلمة «فلستونس»، كناية عن الرابط الوطيد بين أرضين عشقتهما واعتبرتهما وطناً واحداً لها.
لم تكن ريم تؤمن بأولويات القضايا، بل كانت «متضامنة مع قضايا العدل ومع كل المسحوقين في هذا العالم». وهي، ابنة الأرض المحتلة، وضعت بالموازاة النضال من أجل القضية الفلسطينية مع معارضة الأنظمة العربية الديكتاتورية، مؤمنة أن الطريق إلى القدس يمرّ حتماً برفع شعار الحريّة من المحيط إلى الخليج. جمعنا لقاؤنا الأول بها سنة 2009، أي تحت نظام بن علي، وكانت تلك أول عودة لها لتونس منذ التسعينيات، فتحدثنا و«أرجلنا» واغتنمت هي الفرصة لتلتقي بعض الطلبة اليساريين المنتمين إلى صفوف المعارضة من الاتحاد العام التونسي للطلبة، من دون اكتراث للرقابة.
بثت الإذاعات المحلية أغانيها طوال يوم أمس
كانت الدعوات الرسمية لريم بنا في تونس غريبة آنذاك، إذ يطلب منها الحضور لمراسم تكريم، لكن لم تتم دعوتها مرة واحدة للغناء، خوفاً، لا شك، مما قد تقوله على خشبة المسرح، معلنة بذلك مواقفها من النظام الديكتاتوري التي لم تخفها أبداً على مواقع التواصل الاجتماعي أو في تواصلها مع رفاقها خلال زياراتها لتونس. فريم بنّا ساندت انتفاضة الحوض المنجمي التي عرفها الجنوب التونسي في 2008 والتي مهدت للثورة. وكلّما أقامت بيننا، كانت الشرطة تلاحقها بما استطاعت من السرية في تحركاتها الشخصية. فكنّا نطلق على المخبرين لقب «مواسم البنفسج» – عنوان إحدى أغاني ريم- سخرية، إشارة إلى اللون البنفسجي الذي كان لون الحزب الحاكم آنذاك. كما ساندت ريم الاحتجاجات التي أودت بزين العابدين بن علي من الحكم، وكانت أول من دُعي إلى تونس للغناء بعد الثورة، فغنت النشيد الوطني على خشبة المسرح البلدي في العاصمة، ورفعت، جنباً إلى جنب، علمي تونس وفلسطين.
بعد الثورة، لم تخف مساندتها لليسار التونسي عندما غنت في الحفلة التي نظمها حزب العمال في مناسبة الذكرى الأولى للثورة بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) 2012. احتفظت برمزية هذا التاريخ عندما اختارته، سنة 2013، لإصدار ألبومها الأخير «تجليات الوجد والثورة» الذي سجّلته في فضاء «النجمة الزهراء» في سيدي بو سعيد، في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وكان أول ألبوم تلحّن جميع أغانيه. كان اختيار سيدي بو سعيد التي تحتضن عدداً من مقامات الأولياء الصالحين تجاوباً مع روحانيات الأغاني التي كانت في معظمها قصائد لشعراء صوفيين مثل الحلاج وابن عربي ورابعة العدوية. لكن تونس كانت حاضرة كذلك بلهجتها وشعرها من خلال أغنية «الرجل الحرّ» التي تقول فيها: «الحرّ مهما ادّمر لا يساوم […] يموت واقف وسلاحه معمّر».
ريم بنّا تضامنت مع التونسيين في مختلف الأحداث التي تلت الثورة، من مخيمات اللاجئين في الجنوب إلى اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكانت مواقفها دائماً واضحة وبلا مساومة. تضامن وحب لم ينسه التونسيون البارحة، إذ حزنوا لفراقها ووجدوا في برمجة الإذاعات المحلية التي بثت أغانيها طوال النهار صدى لوجعهم. على صعيد رسمي، أعلنت وزارة الثقافة التونسية نيتها تنظيم سهرة لروح «أيقونة فلسطين» في الأيام القادمة. وإن كانت هذه التحية أقل ما يمكن تقديمه لذكراها، فلا يجب أن ننسى أن ريم بنّا لم تكن تحب المواكب الرسميّة وبهرجتها. عسى أن تكون هذه السهرة إذن ترجمة لشخصها وفنّها: سهرة «فلستونسية» تحت شعار المقاومة والحبّ، مفعمة ألواناً… وبلا مساومة.
تراجيديات ريم بنّا

تبدو كأنها واحدة من تلك الشخصيات الخارجة من الأساطير الإغريقة القديمة. مسار حياتها، لا بدّ من أنه قادها لأن تكون، تجسيداً لهذه التراجيديا التي امتازت بها تلك الشخصيات. تراجيديا في حدّها الأقصى، والتي لا تتوقف عن طرح العديد من الأسئلة حول الوجود والوطن وهذا الجزء الإنساني الذي يقبع في داخل كلّ واحد منّا. شخصيات الأساطير الإغريقية، وإن كانت ذات صبغة إلهية، إلا أنها أيضاً، تقع في هذه الصبغة الإنسانية، البشرية، التي لا تتوقف عن الانبجاس في لحظات كثيرة، خلال مسارنا الأرضي، وخلال صراعنا اليومي، بحثاً عن حق في وجود، لا يزال يهرب من أمامنا، ولا يتيح لنا بعد أي فرصة بالإمساك به.
هكذا تبدو تجربة ريم بنّا التي غيبها الموت، صباح السبت المنصرم، لتفقد فلسطين – التي تفقد الكثير من الأشياء مؤخراً – وجهاً بارزاً من وجوه ثقافتها الجديدة، التي خطتها في السنين الماضية.
أولى هذه التراجيديات، ولادتها تحت الاحتلال، حيث يفقد المرء كل شيء: بدءاً من الأرض والوطن، وانتهاء بأقل حقوقه وواجباته الإنسانية. إلا أنها استطاعت أن تتخطى هذه العقبات، ليأتي صوتها، شبيهاً بمنشدات معابد الإغريق، اللواتي كنّ يصوبن المسار ويذكرن بما علينا القيام به كي نستمر في رحلة البحث. البحث عن خلاص من هذه القيود التي فرضتها الآلهة، والبحث عن إقامة بعدما شتتنا البحر لعقود، في سبيل العودة إلى إيثاكا.

هذا النشيد، الذي أطلقته ريم بنّا، أتى مخالفاً لما اعتدنا عليه في أناشيد الثورة الفلسطينية، التي كانت سائدة في فترة من الفترات. كان يحمل وجعاً مخالفاً، وحنيناً مختلفاً. هو حنين ينبع فعلاً من «النوستوس» الإغريقي القديم، الذي يذكر ببديهيات عدّة، لعل أبرزها، تذكيرنا ببديهية الإنسان الذي نحن عليه. فالمقاتل والثوري، هو إنسان يتوجع ويحب.. وليس فقط محارباً يريد أن يهدم الجبال. استطاعت ريم بنّا أيضاً من خلال نشيدها هذا، أن تأتي بجديد إلى الأغنية الفلسطينية وإن كانت لم تتخلّ عن شرطها التاريخي. غالبية الأدب والفن الفلسطينيين، المعاصرين، بقيا محكومين بهذا الشرط التاريخي. بالتأكيد ليس علينا التخلي عنهما، ولكن علينا أيضاً أن لا نتناسى الشرط الإنساني. أن نزاوج بينهما، عبر الشرط الفني الحقيقي. فن حقيقي قدمته ريم بنّا خلال مسيرتها التي انتهت على عجل، بسبب المرض الذي فتك بها.
هذا المرض، يُشكل تراجيديتها الثانية. ومثلما حاربت المحتل الذي استوطن بلدها، كان عليها أن تخوض نضالاً ثانياً ضد هذا «الشيء» الذي احتلّ جسدها. معركتان غير سهلتين أبداً. لا تتطلبان الصبر فقط، بل احتمالات المواجهة من جميع الجهات. حين يصيبك المرض الفتاك، لا بدّ أن تضع نصب عينيك احتمال الرحيل بالدرجة الأولى، ولكنك تضع أيضاً احتمال الأمل، مهما بدا طفيفاً. لا تستطيع أن تعارك بدون أمل ما. ولغاية لحظاتها الأخيرة – ومثلما كانت تكتب على صفحتها الزرقاء الافتراضية – بقيت ابنة هذا الأمل الذي لم يتوقف. لا معنى، ربما، لأن تكون ثورياً ومحارباً، بدون حلم الأمل الذي يقودك. إنه الدرس الأكبر الذي علمنا إياه عوليس، بعدما تاه في البحار لسنين طويلة. لم يفقد أمله بالعودة إلى بينيلوب وإلى إيثاكا.
بهذا المعنى، تقترب ريم بنّا كثيراً فيما كان يقوله محمود درويش، في الشريط السينمائي الذي أخرجه الفرنسي جان – لوك غودار. في إحدى لقطات الفيلم، يعتبر درويش أنه «آخر شاعر طروادي». والمقصود أننا لم نعرف شيئاً عن حرب طروادة، إلا عبر السيرة التي كتبها «المنتصر»، أما الضحية فلم يكن لها الحق بالتعبير عن أي شيء. لهذا أراد أن يكتب انطلاقاً من كونه الضحية، لعلّ العالم يسمع صوته.
كانت ريم بنّا تشكل «ضحيتين» في الوقت عينه: ضحية طروادية أحرقت مملكتها الجيوش الآتية من الخارج، وضحية الوحش الذي أتاها من الداخل. لكنها لم تجد بدّاً من المواجهة وإن كان ذلك عبر الكلمة واللحن والصوت. أدوات تبدو في كثير من الأحيان أنفع وأمضى من أشياء أخرى، وإن كانت لا تنفيها بالطبع.
مثلما حاربت المحتل، كان عليها أن تخوض نضالاً ثانياً ضد هذا «الشيء» الذي احتلّ جسدها
ومع هذا المسار، كان لا بدّ للشخصيات الإغريقية أن تقع أحياناً في أخطاء مميتة. وقد يكون هذا الأمر، التراجيديا الثالثة. لعل ما يشوب هذه المسيرة، خطأ ريم بنّا الذي اعتبرته «زلة ثورية» عادت واعتذرت عنها في السنوات القليلة الماضية. قيل يومها إنها صعدت على مسرح مع فنانة إسرائيلية، وقيل إنها أنشدت «للسورة» قبل أن تكتشف مسارها الحقيقي. عديدون هم الذين سقطوا في فخاخ ذلك. لم تكن الوحيدة في ذلك. وليس كلامي هنا تبريراً لهذا الخطأ، لأني لا أفهم حقاً، (ولا يمكنني أن أقبل) كيف يمكن لفلسطيني أن «يحارب» في بلد آخر، شعباً آخر، بينما عدوه على أرضه.
في حضرة الموت علينا أن نتمهل قليلاً. علينا محاكمة الشخص وهو على قيد الحياة، لا حين يرحل. على الأقل فنحن لو فعلنا، فإننا نحرمه من أبسط حقوقه: الدفاع عن نفسه. إذ لن يتمكن من ذلك بعد أن غادر.
تغادر ريم بنّا مع بداية الربيع. تغادر عشية «القيامة» عند الطوائف المسيحية. لعلّ الربيع الحقيقي يأتي من أرض فلسطين. لأنها أرض القيامة المجيدة.
شهادات
تركت لنا شجاعتها
باسل زايد *
كنت طفلاً يستمع بشغف إلى كل ما هو موجود وكانت أغاني ريم بنا، وكبرنا وظلت ريم بنا ورحلت وستظل شخصية ريم بنا. رحيل ريم هو رحيل علاقتنا جميعاً مع ريم، فالكثير من الأسماء نعتبرهاً جزءاً من حياتنا إلى أن تغيب. غابت ريم، ولكن تركت مواقفها وأغانيها التي استخدمتها للتعبير عن هويتها. كنت مختلفاً معها في الكثير من الأمور الفنية والسياسية وغيرها، ولم أقل لها بحكم الزمالة الفنية. أما الآن، فقد أعطتني الفرصة لاختلف معها اختلاف الجبناء. غادرت ريم، ربما تعبت، وربما حان وقت الرحيل، لكن بالنسبة لي خسرت فرصة أن أعبّر عن اختلافي مع ريم. لكن الأهم أنها كانت شجاعة بتعبيرها عن نفسها ووطنيتها وإنسانيتها. رحلت ريم وتركتنا نتذكر شجاعتها. مع السلامة ريم بنا
* موسيقي وملحن فلسطيني
ذاكرتي الطفولية
محمد نجم*
ارتبط صوتها بفترة طفولتي حين كنت استمع إلى أغانيها التي كانت تلعلع من مسرح «العمل الكاثوليكي» في بيت لحم. كان مسرحاً مكشوفاً وعلى ارتفاع يطل على مدينة بيت ساحور. تمنيت وقتها، أن أقابلها شخصياً، أذكر بأن أغاني الأطفال التي كانت تؤديها كانت تحاكيني، وصوتها كان يرافقني كصديق وفيّ يواسيني ويشجعني عندما كنّا نلعب كرة القدم في بيت ساحور!
فِي يوم من الأيام، جالت سيارة بمكبرات صوت تعلن بأن ريم بنا ستغني في بيت لحم. وجدت ساقيّ تتوجهان مباشرة الى ساحة «العمل الكاثوليكي»، واستطعت يومها أن أحصل على أوتوغراف منها مع ابتسامة عريضة وترحيب كبير.
بعدها بسنين شاركت في المهرجان نفسه الذي غنت فيه في «مهرجان يابوس» في قبور السلاطين. ذهبت لأحضرها كأنني أريد أن أسترجع بعض ذكريات طفولتي. مرت الأيام والسنون وغمرت بحب أعمالها وخاصة «مرايا الروح. في العام ٢٠٠٩ دعت اوركسترا فلسطين للشباب كلاً من ريم تلحمي وريم بنّا للمشاركة مع الأوركسترا حيث أدت بنّا أغنيتها التي حاكتنا كلنا وأبكتنا «ساره» (الطفلة التي قتلت في بيت لحم من قبل الجيش الإسرائيلي). وحصلت على شرف مشاركتها المسرح نفسه. وهنا أودّ الشهادة بصدق وشفافية ريم! إذا لم تكن تعرفها، فربما اعتقدت أنها كانت تبالغ في كل مرة كانت تتحدث عن فلسطين وعن النضال وعن ضرورة الصمود، سواء على المسرح أو خارجه. بل كانت فعلاً مشغولة ذهنياً وعاطفياً ومغمورة بالقضية، كما أنّها كانت ابنتها أو قضيتها الشخصية!
ريم كانت مع ابتسامة غير مفارقة لوجهها بشكل دائم. تحترم وتحب كل من حولها، وفراقها الْيَوْمَ شكل لي صدمة، كأن جزءاً من ذاكرتي الجميلة غادر وتلاشى! ريم المجسدة بصوتها وفِي شخصيتها، المقاومة للمرض والاحتلال وكل المصاعب التي مرت فيها، لم يستطع هذا الخبيث أن يغلبها أو يخفي ابتسامتها، رغم أنّه كسر أحد حبال صوتها الحريري.
* عازف كلارينيت فلسطيني
الطاقة الجارفة
يوسف زايد*
ما زلت أذكر كأن ذلك كان بالأمس، صاحبة البريق القوي في عينيها، ريم بنا الطاقة الجارفة، كنت يومها مشاركاً في «مهرجان القدس». فبقيت في مدينة القدس لأيام عدة، وحالفني الحظ أن أستمتع بعرضها الموسيقي في قبور السلاطين. كنت ما زلت طالباً في معهد الموسيقى آنذاك. بعد العرض، ذهبت لتحيتها على أدائها الرائع لأنّه أعجبني حضورها القوي والعفوي. تملأ المسرح وحدها. المسرح شيء مخيف، لكن أظنّ أنّ المسرح كان يخاف ريم. موسيقى قريبة للقلب وكلمات أقرب. بسمة من القلب وعلاقة خاصة مع الجمهور.
أديت التحية وشعرت فوراً بأنني زميل لريم كأنّها تعرفني من 20 سنة. سألتني ماذا أفعل، فأخبرتها عن نشاطي الموسيقي، فقالت جملة واحدة مع بريق العينين نفسه: «شي بيجنن، لازم كمان وكمان. موفق» وخلص.
اليوم استيقظت من النوم ووقعت عيناي أول شيء على البريق نفسه في صور التعزية على الفايسبوك، وأنا أعلم بقوتها وشجاعتها وهي تقاوم المرض. لم أستطع أن أفهم.
لم يحن لهذا البريق أن ينتهي، لن ينتهي هذا البريق.
* موسيقي فلسطيني
رثاء فايسبوكي
«لا تخافوا ..هذا الجسد كقميص رثّ.. لا يدوم حين أخلعه (..) سأهرب خلسة من بين الورد المسجّى في الصندوق وأترك الجنازة وخراريف العزاء..»، بعض من كلمات دوّنتها ريم بنّا (1966-2018)، في 5 آذار (مارس) الماضي، على صفحتها الفايسبوكية، لتكون تدوينة رثائية أخيرة، تستوقف آلاف المتابعين/ ات على الشبكة العنكبوتية، ويتناقلها أكثر من 21 ألفاً، ويعجب بها أكثر من 60 ألف متابع/ة. الفنانة المناضلة لم يبخل عليها هؤلاء، وآخرون من جنسيات عربية متعددة، بكلمات الرثاء وإعادة نشر صورها الشخصية، المقرونة بإرادة وابتسامة لا تهزمان.
شخصيات عامة، ومعروفة، رثت بكلمات بسيطة، «غزالة فلسطين»، وعبّرت عن حزنها القاسي، إزاء رحيلها المبكر. الكاتب والباحث الفلسطيني زكريا محمد، اعتبر أنّ خسارة ريم بنا، التي تعدّ «من أجمل نساء فلسطين وأعظمهنّ»، هي خسارة للصوت «الذي فتح باب الفرح الى قلوبنا وقلوب أطفالنا»، مضيفاً: «أنا شخصياً مدين لريم البنا بالكثير. لقد تربى أولادي أطفالاً على أغانيها». أما الفنانة الفلسطينية سناء موسى، فقد حيّت روح ريم، بالقول على صفحتها الفايسبوكية: «أول الفنانين الذين قاطعوا الاحتلال ثقافياً، أول من أعاد إحياء أغاني التراث الفلسطيني»، مضيفة: «سنبكي، سنغترب سنبحث بين الأصوات عن صوت يشبهك، كما يبحث يتيم عن أم وأب، ولن نجد وسيبقى صوتك يأخدنا الى فلسطين كلما سمعنا أصغر التفاصيل به». الفنان مارسيل خليفة دوّن معزياً: «إيه، يا ريم سأقطف الكون كما لو كان فاكهة سماويّة وألقي به في يدك الورديّة ! ريم البنّا شكراً لكِ». أما الفنانة تانيا صالح، فقد دعت عائلتها «بيلسان، قمران، أورسالم، زهيرة وفراس»، وكل أبناء الشعب الفلسطيني لأن «يكونوا أقوياء»، كما «علّمتهم ريم»، وأضافت: «صوتها بيضل عايش بقلب كل حرّ على هالكوكب.. سلام لروحك يا صديقتي».
بدوره نشر الفنان الفلسطيني محمد عسّاف، صورة للفنانة الراحلة، مذيلة بتدوينة على تويتر: «رحلت بعدما ملأت دنيانا حباً، فناً وأهازيج كانت من فلسطين ولفلسطين تغني (..) حاربت السرطان بشجاعة وأمل..أشكرك..نحبك..». زميله نجم «آراب أيدول» العام الماضي، الفلسطيني يعقوب شاهين، رثا الراحلة أيضاً، قائلاً: «رحل الجسد ويبقى فنها يذكرنا أن نروي قصة مقاومتها للمرض والظلم..».
«صوت القضية بحّ صباح اليوم… ترنيمة فلسطين المقاومة رحلت»، كلمات قليلة دوّنها الإعلامي اللبناني نيشان على تويتر، ناعياً الفنانة الراحلة. لبنانياً أيضاً، دوّنت الممثلة رولا حمادة على حسابها على تويتر قائلة: «حملت فلسطين بقلبها وصوتها ومشيت وما تطلعت وراها، خبرت اولادها أنها رايحة (..) زتت وجعها عالعتبة هي فالة وغابت». بدوره، نشر الفنان المصري محمد محسن، صورة تجمعه ببنا، مقدماً العزاء لعائلتها ولأسرتها ومحبيها. كذلك فعل الممثل المصري محمد هنيدي، الذي غرّد بكلمات من أغنية «الغائب» لريم مدّوناً: «لا تعتذر من قال إنك ظالم… من قال إنك معتدي».
 موقع هوا لبنان
موقع هوا لبنان