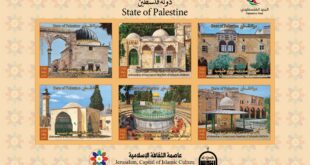إلى عاصي الرحباني…
“دقيت طلّ الورد عالشبّاك”، وأطلّ وجه أمي. منذ سنين حين شاهدت وجهها للمرّة الأخيرة وعدت بين البيوت صبيّاً ودّع غفوة أمه إلى الأبد. تسرّب من إحدى النوافذ صوت “فيروز“: “ماتت لشو تخبر\ أنا وياك\ وحدنا يا ورد\ رح نبكي\”.
البارحة رأيت مجدداً وجه أمي فودعته ثانية بوجه “عاصي” الأغنية نفسها رافقته وهو في طريقه الى تراب الورد. لا أعرف كيف إختلط وجه أمي بوجهك يا سيدي. أهو الورد، أم نداه، أم برودة الجبين؟ (لم ألمس جبينك، لكنّي ذقته بشفتيّ عندما كنت صغيراً في جبين “ماتيلدا”. ماتيلدا هي أمي.
لا أعرف سرّ هذا الشعور الذي انتابني وأنت تغادر من بوابة المتحف. أحسست أن كل الشبابيك في المدينة فتحت، وكل بواباتها فتحت، وأنت تعبر بوابة المتحف.
لا أعرف سرّ هذا الشعور، لكني أذكر جيداً حين كنت أراك ذات يوم بعيد. أذكر وجهك جيداً حين يطلّ وتتحوّل الضيعة الى ساحة من ساحات أعيادك. كنت أحيّيك متهيباً إذ أنّي أعرف “المقام“ وكنت شغفاً ومولعاً بحبّات النغم. وحين كنت تغادر أعود إلى وجه أمي وأراه مشرقاً يحرضني على أجوبة لأسئلة كنت أقرأها في عيون “ماتيلدا” أخبرها عن إطلالة عاصي، عن كلامه، عن ابتسامته، عن نكته، وأخبرها عن تهيّبي أمامه. فتذكرني بأن لي موعداً مع أستاذي في التمرين على الآلة.
إنني حزين حتى نهايات الأغنيّة. إنني حزين وما بوسعي إلاّ أن أنثر عليك وأنت تعبر بوابة المدينة كل أغنية، كل ورد، أجمع من حقول البريّة كل العشب، وكل الزهر، وكل الشوك. وأركض صبياً حافي القدمين في كل القرى والمدن لألملم حلمك وأعيد نسجه وغزله كي ألغي كل بوابات المدن وكل الحواجز التي منعتني أن أمشي خلف جسدك النبوّي أو أمشي الى البيت. أركض في ضيعتك التي امتدّت الى أطراف الخيال. أركض في ثيابك وفي يديك، في اطراف أصابعك وفي عينيك، في نطقك، في عتابك، في حنين وترك، في الموّال البلديّ مساء، في كلّك. أركض إلى الزمان لأعيد إليك كل شيء كان ينتظرك وأنت تمشي إلى الحب، إلى الفرح وإلى الحريّة.
لو عدت يوماً ومررت قرب الدرج الطويل الذي أرى فيه من بعيد كمدخل لمعبد قديم، لقبّلت الحجارة والعشب ورحت أقرأ – حيث غفا وجه أمي – كل الشعر الذي كتبته ورحت أرتّل كل الالحان التي صغتها ورحت أغني كل الغناء الذي أنشدته ثمّ كتبت على كل شجر “الكينا“ وكل الشجر البرّي وكل حجارة الضيعة حلم عاصي وفلسفة عاصي. وأترك للموج يمحو على الرمل ما كتب عليه حين رسمت باصبعي الطري دوائر وأشكال وكنت أرى في البعيد حلماً ووجوه وملائكة.
لو عدت يوماً إلى هناك لنصبت الخيام.
لو عدت يوماً الى هناك لقرعت الطبول. وأقمت عرساً غجريّاً ترقص فيه كل الجميلات.
لو عدت يوماً الى هناك لأنرت مليون شمعة يحملها مليون طفل، يمشون بها وبأكاليل الغار وأغصان النخل والزيتون – كأحد الشعانين ـ ويكون القمر بدراً عند الزمان ووجه عاصي قمر.
( حين بكى الطفل وأراد أن تقطف له أمه القمر، أتت بدلو الماء وصوبته الى السماء، مدّ الطفل يده إلى الماء فانكسر القمر، ضحك الطفل ثمّ نام )
ماذا تراك فعلت بي يا عاصي.
صحيح أن الولد ضحك ثمّ نام. أمّا أنا فبقيت ساهراً ألملم تناثر القمر على وجه ذاكرة تموج كالماء الهارب من الولد ليغطّي مساحات شاسعة من الزمن. يصبح ماء الدلو جدولاً نهراً بحراً ضجيجاً غناءً رقصاً سكراً عرساً وجعاً ناراً تصهر كل ما قسا فيّ وتحجّر، وتعيده جديداً نديّاً نقيّاً مثل قربانة أولى أو مثل قبلة أولى.
أعود بالذاكرة إلى الماضي لا لأجل إجترار الحنين، بل لأرتوي وأرتاح وأخزّن مؤونة قبل متابعة الطريق صوب الغد الذي أراه واضحاً عادلاً جديداً وكما أراده “عاصي“ أو تصوّره. عودتي الى الماضي رقاد جميل لا يمنعني من الحلم الفاعل، من الحلم بوقت علنيّ قادم لا محالة.
لعاصي قرأته يصقل مرآة للقمر على صفحة الماء. أتصوره يضحك كالطفل أمام انكسار القمر. هناك قدم أقوى من يد الطفل ! قدمك يا عاصي، تمشي على الماء وتصل “ولو بعد مليون إشارة“ ونصير لا نفرّق : أيهّم فتات القمرالمكسور وأيتهم أثر أقدامك على صفحة الماء الوعر.
لعاصي عدت صبياً حافياً يركض في الماضي ولا يلبث ان يكسر كل البوابات وينير شمعة أبديّة في خاطر مدينة البحارة.
كل شيء قلته يا عاصي جميل، كل بدوية في كلامك، كل إمرأة كل الرجال، كل طفل ثمّ كل الاشياء.
كل شيء عرفت أن تقطفه تمد يدك وأحلى زهر في البريّة تسوّي منه باقة. تمد يدك وتعمّر أجمل البيوت والحجر “صوّان“ دائماً تبقى على الحلم الذي عشّش في كل البيوت، لأنك ولع بالحريّة مبغض للاستعباد. لذلك يا سيدي الانسان فيك والفنّان المرهف لن يغادر حقول القمح والحصادين والبحّارة.
عاصي
أنت غني، غني، غني، غني، رغيفك طيّب المذاق وقوت كبير لمن يمر بضعف في العزيمة.
عاصي،
كلمة أخيرة : كلامك الكبير يجعلنا نخجل ألاّ نحاول أن نكون كباراً.
قلبي على جبينك البارد، ودمعة على ترابك…
بيروت ٢١ حزيران ١٩٨٦

 موقع هوا لبنان
موقع هوا لبنان