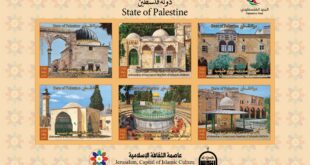لكفررمان… زهرة بريّة حمراء ودوّار يهتف للخبز والحرية
- الكاتب محمد ناصر الدين
أصل الاسم: الرمان، اسم الشجر المعروف، أو قرية رمّون أو رمّانا، rummãna (سريانية)، وقد كان شجر الرمان، وعلى وجه التدقيق زهره الجميل، الجلنار، رمز هذا الإله السامي القديم، ورمّون أو رمانا كان إله العاصفة والبرق والرعد (ربما اسمٌ مشتق من رعم وهو إله النبت والخصب، فيكون الاسم: قرية الرمان. ترتفع 450 متراً عن سطح البحر، من أعمال قضاء النبطية، وعلى مسافة 3 كلم منها في الشمال الشرقي، وقد قال الشيخ سليمان ظاهر عام ١٩٣٤ عنها: «أخذَت مكاناً عمرانياً بهمّة الزعيم يوسف بك الزين، وزادها تحسيناً جره إليها قسم من ينبوع نبع الطاسة. فشاركت النبطية في الازدهار، والبلدة قديمة وفيها آثار تدل على قدمها، منها: قلعة دير عجلون، وبرج كفررمان، والسويداء، وبرج الميذنة وتتبعها تلك طهرّة». لكن عروس القرى تلك لم تحب البيك، أغوتها زهرة بريّة حمراء في الحديقة: كفررمان المنجل، كفررمان المطرقة، كفررمان الكلاشينكوف، كفررمان المحاريث الموجهة إلى القلوب السمينة الفاجرة، كفررمان انتفاضة مزارعي التبغ عام ١٩٧٢، كفررمان الميبر، كفررمان حكمت الأمين يطوف على الفقراء ليلاً بالسماعة وربطة الخبز، كفررمان الرصاص يزغرد عند تلة السويداء، كفررمان الدوار يهتف، يرقص، يغني للحرية والخبز، لزمن وردي حسبنا أنه أفل إلى غير رجعة.

(لكفررمان ودوّارها)
«كانَ ياما كانَ من عشرين عامْ
قريةٌ أجملُ من مَلْيونِ عامْ
ينحني بين يديها النهرُ
والريحانُ يُهديها السلامْ
وهي أدنى من قطيعِ الغيمِ أمتاراً،
وأعلى في المقامْ
من مدينَة*…»
أحمد والحسناء (1950)
من أعلى تلة تشرف على قرية الرمان، كان أحمد يبصرها تغتسل عاريةً في «السبلة»، عليه أن يقطع الوعر كلّه مشياً على قدميه، ليصل إلى الوادي ومنه إلى سوق النبطية. أوصته أمه أن يشتري حبّ «الماش» لتسمين البقرة. المرأة العارية في الأسفل أجهزت على ذاكرته بأكملها. «ماش ماش» أوصته أمه، هكذا تردّد الكلمة من «خلّة زينب»، آخر نقطة في الحبل الرفيع حتى تصل إلى السوق. ظلّ أحمد يلهج بالكلمة على لسانه. عند كعب الوادي كانت الحسناء قد توارت خلف الحقول. التقى أحمد بصيّاد السمك قرب الجسر. «ماش ماش»، سمعها الصياد وقال لأحمد هذه تعويذة النحس. قل: «تلاتي كبار وأربعة زغار» واغرب عن وجهي. وصل أحمد إلى أول كفررمان وهو يردّد ما أوصاه به الصياد. مرت جنازة عند أول البيوت، ردّد أحمد «تلاتي كبار وأربعة زغار»، فانهال عليه أهل الفقيد بعصيّهم. قل «مات الله يرحمه» ألا ترى الحزن في الوجوه، قالت له الأرملة. ردّد أحمد ما أوصته به الأرملة، ليجد كلباً ميتاً في منتصف الطريق ويلتقي رجُلاً أزعجته رائحة الجيفة. طردَه الرجل قائلاً إن الرحمة لا تجوز على الكلب. قل «كلب وراح من الدرب» أيها المعتوه. وصل أحمد إلى دكان الحلّاق قرب الدوار، أراد أن يحز ذقنه التي صارت كجميزة الحقل. كان البيك يصفف شعره، وأحمد يردّد الجملة العجيبة. انهال عليه رجال البيك بقبضاتهم وأوصوه أن يقول «نعيماً». وصل أحمد إلى سوق النبطية ليجد لصاً كان التجار قد أوسعوه قصاصاً، قال له أحمد: نعيماً نعيماً. رجع أحمد بخفي حنين عند المغيب إلى سجد، يبكي على الحسناء التي اغتسلت بدمع عينيه.

العين والمخرز (1771)
وين مير الحرب يوسف يوم صال من عرب صاليم عالوادي نزل
في جيوش عدادها تسعين ألف أو تزيد عداد خوفا ان هزل
جاهلين الحرب ما يدروا الزمان مؤمنين الدهر وصروف النكل
يا علي الفارس يعارك في الجموع شبه ليث صال وأشجع من بطل
وأذهل الأبطال ركض الصافنات لعبت الفرسان في ذاك المحل
كانت عساكر الأمير يوسف الشهابي تنزل كالسيل، وكان جيش الأمير ينزل في أربع فرق، فالفرقة الأولى وهي المقدّمة وفيها الأمير يوسف في أول الجيش. والفرقة الثانية، وهي الجناح الأيمن كانت تصير في طريق جباع – فحومين – فحبوش فالنبطية وتحرق القرى والدساكر والبيوت في طريقها. والفرقة الثالثة، وهي الجناح الأيسر كانت تسير في طريق العرقوب – فالميذنة فالجرمق – فكفرتبنيت فالنبطية. والفرقة الرابعة، وهي القلب كانت تسير في طريق جرجوع فعربصاليم فالنبطية.
وكانت قوى الشيخ علي الفارس وأخيه الشيخ حيدر الفارس مؤلّفة من فرقتين من الفرسان وعددها خمسماية من الأبطال المجرّبين كانت تقيم معه في قلعة الشقيف، وفرقة المشاة وعددها ألف مقاتل من الشبان المتمرنين على تسديد الرماية جمعَها من النبطية والضواحي. وعسكر الجيشان بجيشهما في الضاحية الشرقية من البلدة في أرض تسمى (قلادش) التي عرفت بعد المعركة – بعريض القهوة – ولم تزل بهذا الاسم حتى اليوم لأن عسكر يوسف الفارس شرب فيها قهوة النصر والظفر.
وعقد الشيخ علي الفارس ديوان مشورة من خواصه وكبار رجاله، وخيّرهم بين التسليم والخرب، بل بين الموت الذليل والحياة العزيزة، بين حرب مجزية أو سلم مخزية وراءها سبي النساء والاستعباد وأخيراً دمار البلاد، فاختاروا الحرب وصلّوا جميعاً صلاة الموت ودعوا الله أن ينصرهم ويخذل العدو الباغي عليهم. وصلت مقدمة المهاجمين إلى النبطية وفيها الأمير يوسف الشهابي، فاحتلت الضاحية الغربية من البلدة، ونصب الأمير سرادقاً كبيراً على البيدر الأعلى قرب الجبانة، وأصبح الناس يرون مخيم الأمير وفي أعلى السرادق كرة من الذهب تشع في نور الشمس. واجتمعت فرق الجيش كلّه في كفررمان واتّخذتها مركزاً. ولما انفرد الأمير الشهابي عن الجيش وآوى إلى سرادقه آمناً مطمئناً كأنه يسير في نزهة معتزاً بكثرة جيشه، رأى القائد الصعبي وهو الباسل المحنّك أن الفرصة سانحة فعوّل على الهجوم بالفرسان بعد أن كانت الخطة دفاعية، وخشي بادرة الحماس من الشبان المشاة فأمر بحبسهم في دارة آل الفضل في النبطية، وأمر قائدهم أن يوصد الأبواب ولا يدع أحداً يتحرّك إلا بإشارته، وعبّأ خيالته تعبئة حربية محكمة.

فأحاطت بفرقة الأمير من جهات ثلاث من الغرب والشرق والجنوب تاركاً جهة الشمال ليسهل طريق الفرار والانسحاب وبدأت المعركة بإطلاق الرصاص، فذعر الأمير يوسف، وتشوش جنوده، فالتجأ إلى الفرار راكباً بغلة لا يلوي على شيء. نقب الشباب جدار الخان الشمالي في دارة آل الفضل، وتعقّبوا العدو واشتبكوا معه في ساحات ثلاث (في الجزائر) شمالي البلدة، (ووادي بو نعيم) شرقيها، وبين زيتون كفررمان. وكان جيش الشيخ ناصيف المؤلف من ثلاثة آلاف مقاتل قد وصل إلى قرب قرية شوكين وهناك التقى بكشاف يقول: «علق الشر، علق الشر» أي دارت رحى الحرب، فأسرع برجاله سالكاً طريق زبدين، ودخل البلدة من الجهة الغربية ليدهم مقدمة الجيش المخيمة غربي البلدة، وتنكب عن طريق «نبعة حبيب» لأنها مضيق واقع بين جبلين وسار بخيله خببا إلى ساحة العراك ورأى الحرب قائمة على قدم وساق فهجم هجوم المستميت، ولم يليث العدو أن لوى عنانه متقهقراً إلى كفررمان. ولما مالت الشمس تحاجز الفريقان وأسدل الليل سدوله فانتشر جيش ناصيف والفارس يوقد نار الحرب ويهزج بالعتابا…وفي اليوم التالي تعقّب جيش ناصيف النصار الأمير الشهابي فأدركه في عقبة جرجوع، فقنّع رأسه بالرمح ثم عفا عنه.
مسدّس الكولونيل (١٩٨٥)
«أربع مطاحن داروا والهوا غربي
أربع نهورا ما يشفو ظما قلبي»
كان هذا الحداء من أمه مريم آخر ما خطر في بال علي قرب المطحنة عند الوادي الأخضر، حين انكشف أمر مجموعة المقاومة التي تعبر النهر في آخر كفررمان، إذ عثرت رجل مصطفى، أحد أفرادها ليسقط في «الدوّار» محدثاً جلبة عظيمة. انتبه الكولونيل الإسرائيلي ابراهيم حيدو ورجاله أعلى الجسر، وصارت المجموعة التي في الأسفل «محروقة» مثل كف اليد. أراد جنود العدو أن يعالجوهم بالرصاص لكن الكولونيل أحبّ أن يصفّي حساباً شخصياً مع علي. لا تطلقوا النار، سأصفيه بمسدسي هذا. «جنّي» جبل الريحان، هكذا كان جهاز الأمن الإسرائيلي يسمي المقاوم الذي أذاقهم «زوم الزيتون» في جبل الرفيع وإقليم التفاح. أفلت علي من أيديهم مرات عديدة، واستذكر حيدو أن جندياً على الحاجز أخبره مرة أن امرأة محجبة مرت على الحاجز مكتوبٌ على تذكرتها «زينب الخميني»: إنها ساعة الثأر لـ «جيش الدفاع» على المخرب. «أربع مطاحن داروا»… يقترب الكولونيل من طرف الجسر، كان علي قد أوصى «جورج»، المقاوم الأخير البعيد قليلاً بإشارة من يده أن يتركهم لمصيرهم ليحصدهم الرصاص. صرخ «جورج» بأعلى صوته «حيدووو»، فارتبك الكولونيل ليعالجه علي بطلقة في جبينه من الأسفل. سقط الكولونيل من أعلى الجسر وشقت المجموعة طريقاً نحو كفررمان ليختفوا من بعدها بحيث لا يعرف الجن الأزرق بمكانهم… تقول الحكاية إن قلب مريم في تلك الليلة قد شرب نهر الزهراني كلّه.
«طالما السماعة موجودة في عنقي فلن يقتلوني» (١٩٨٩)
من هو هذا الرجل الملثّم، الذي يطرق باب الفقراء ليلاً، يُخرج سمّاعته وكيس الأدوية، يستمع إلى أوجاعهم بقلبه، وتعبث يده بلحيته الكثة؟ «قلبي عم يوجعني يا قبّاري»، «خدي هالحبة يا حجة بكرا بترجعي جديدة وبيرجع قلبك يدق متل الطبل لـ «بو حسين». سقط الثلج سميكاً تلك الليلة في موسكو، كان الفتى الجنوبي يفكر في عصفور عند نبعة «شقحا»، عند سهل الميذنة في «كفرموسكو». حدّق حكمت الأمين مطولاً في البحر، في ذلك النهار من عام ١٩٨٩. الطبيب الأحمر المطارد من كل أجهزة الأمن يودّ لو أن البحر يجيبه على مسألة أنسته لبرهة الطائرة التي تحوم في السماء، فوق مركز الجبهة الشعبية على تل الرميلة. «هل كان تروتسكي على حق؟» أراد الطبيب الوسيم أن يطرح ثاني أسئلته الصعبة على البحر، عن البيك وقصره في قرية الرمان البعيدة. الطائرة تقترب: ليلى، منى، جمال، كانت أسماء أولاده تطفو فوق الموج حين مزّقه الصاروخ.
«قمْ تأمّل ْ*
كلُّ من ماتَ على جلجلةِ الأوطانِ قامْ
لم تَمُتْ هذي العصافيرُ على التلِّ، ولا ماتَ الحمامْ
أنتَ أسلمتَ إلى التلِّ يديك
فانحنى، حتى دنا من مقلتيك
ثمّ غطّى وجهَكَ المحروس، بالرمل، قليلاً، كي تنامْ»
*من قصيدة «فتى الرمان»
للشاعر محمد علي شمس الدين
 موقع هوا لبنان
موقع هوا لبنان