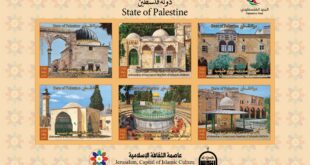أسامة بعلبكي… «العازف المنفرد» على وتر أحلامنا!
للمرة الأولى، بعد عشر سنوات من العمل الفني الدؤوب، المتواصل، والعروض المتتالية، يتاح للزوار أن يروا أعمال أسامة بعلبكي (1978) كلغة متكاملة. لغة واحدة، ملؤها العزف الشاعري، لكن وجودياً، والعازفُ… منفرد! بعلبكي المغرّد خارج سرب النمطية التمرُّدية السائدة في الفنون التشكيلية، يُحتفى بثمار سنوات عمله العشر نُضجاً.

في «غاليري صالح بركات»، أكثر من 45 عملاً بالأكريليك وعشر مائيات، هي مختاراتٌ من أعمال بعلبكي. ثلثاها جديد، والثلث الآخر استعادة من السنوات الماضية. تُحيك معاً روح لغة أسامة البصرية. يصهرها المكان بعرضٍ نوستالجيّ غير خطّي، فيضعها في إطارها الاستيتيقي الأبلغ.
«الأعمال الفنية هي الحلقة الأولى الوسيطة المخصصة لإعادة وصل الخارجي والحساس والزائل/ الهالك، بالفكر الخام. وتوفيقٌ للطبيعة والحقيقة اللامتناهية مع الحرية اللامتناهية للفكر المفهومي» (هيغل).
رحلة بين الزرقة وألوان الغسق
يخفق القلب مع اقتراب موعد الغوص في بحر أزرق بعلبكي. ننزل الأدراج إلى القاعة الكبرى في الغاليري، نلقي نفسنا في يَمّ اللوحات. هي سماوات، شموسٌ وغيومٌ وأشجار… ثم زهرة منفردة، فسيارة صغيرة وأسامة في كل مكان. ثم بيروت ليلاً، بيروت عند الغسق، بيروت وقت الفجر، فبودلير وماياكوفسكي، وفان غوغ! الكنوز في أعماق هذا البحر كثيرة، تدعو للسباحة في كل الاتجاهات، كما تشاء النفس. حُرةً. كفعل رقصٍ، يضبط النورُ في أعمال أسامة إيقاعه. فالتلَفُّت هنا فعل حرية طفولية، ملؤها الاندهاش. نفتح عيوننا كأطفال نكتشف للمرة الأولى ما تعنيه الرؤية تحت الماء. ندرك أن اللَّحظَ يلتقط اللون والنور وحتى النبض. هي الدهشة الطفولية الأولى الرومنسية، تلك التي تحيلنا جميعاً راقصين سابحين في فلك لوحاتٍ واقعية ورمزية وحتى سريالية. أن ترى عيناك لوحات أسامة، يعني أن تقرأ شِعرها، أن تسمع همسها، صراخها الكتوم، وعزفها.

أن تشعر بدفء يدها يلمس قلبك عند التحية، تناديك تلفظ اسمك بصمت عند لقاء العيون. فهي تعرفك حقاً.. وأنت لا تحتاج لبيان كي تعلن حبك لنورها. فقد بُحتَ دون كلام ألف مرة. فهذا الوجد حاصل. هذا القُرب فطرةٌ هي أكثر من يعرفه. لغتها لون من نور، بل جُودٌ من فيض رؤية. هي دعوة لحوار مع الواقع حُلماً لا يجيده إلا المُرهفون. والأزرق يدغدغ العيون. «الأزرق يحيي! الأزرق يحوّل الصور لمادة يمشي فيها ماء. تصير راهنة، حقيقية، حية، خصوصاً المنظر الطبيعي. الأزرق جيلاتين الخيال، يمر بمسام الخيال. من دونه، الصور بلا ليونة» يقول بعلبكي بشاعرية صادقة.
المعرض الذي يشمل أعمالاً منذ 2010 تقريباً ــ الزمن الذي انعقدت فيه الأفكار على شيء ثابت وشخصية فنية ومزاج بصريّ صار يُميِّز أعمال بعلبكي ــ يحوي مراحل متعددة من رُؤاه. من مرحلة العمل على الواقع كخبر صحافي، كالخلاء الذي يحوي دماراً ما أو حادثة، إلى كيفية متابعة الفنان لنفسه. ثم العمل على الطبيعة كحالة موسيقية شعرية، فيها ألوانٌ، ليلٌ ونهار. بل ألقُ الليل وألقُ النهار. وصولاً إلى المدينة ليلاً. «في اللون والضوء، أنا ميال للعتمة ونقيضها. فأنا أرى العالم تقريباً بعيون فيها الكثير من الظلال، وفيها تطرف بجهد الضوء وبالظلال التي ينتجها.
الطبيعة والضوء اللبنانيان، يناسبان كثيراً الأكواريل (أ. ب)
وهناك الغسق، غسق الألوان، موجود. هذه الألوان النحاسية، ألوان العالم كأنه على طرف نهايته. والإضاءة الشبحية قليلاً، الإضاءة التي تحيل العناصر الطبيعية إلى أشباح، سواء من شجر أو رافعات في المدينة أو صخرة أو سيارة، أو مبانٍ في المشهد الليلي كأنها أشباح، أشباح متحركة. تكون الأعمال أحياناً واقعية تعبيرية وأحياناً فيها بعض اللعب الذي يظهر سريالياً. يجب أن أقول إنّ هناك تياراً من سرياليةٍ مضبوطة. سريالية تشبه الخاطرة العقلية! فالسريالية عندي ليست واضحة، لكن لا مانع لدي إن كان المشهد واقعياً جداً، فأضيف إليه علامة فيها تضخيم سريالي. قد يشبه ذلك ميتافيزيقية دي كيريكو، الميتافيزيقية العقلية المنطقية. ففي بعض أعمالي، توجد هذه السريالية المنطقية. وهذا تأثر بالشعر، بقصيدة النثر، بالشعر الحديث تحديداً، الذي هو شعر ذهني. فهذه كلها مفارقات في قلب العمل. واضح أني ميّال للواقع كرسم، أنحت الواقع. لأنني أحب لرسمي أن يكون متيناً ومحكماً» يشرح بعلبكي. لكن المعرض لا يقتصر على اللوحات الأكريليكية المتينة الصياغة والسبك والحبك. هناك أيضاً قرابة 10 أعمال بتقنية المائيات، موقعة بغالبها هذا العام، لمناظر طبيعية من لبنان: «حديثاً اكتشفت بالصدفة أن هذه المادة التي كنت أخشاها، أي الاكواريل/ المائيات، هي مدعاة تحرُّر، كأنك تركضين! هو ركض حر وفيه رشاقة. يجب أن تكون يدك كالخطاط الياباني أو الصيني، خاطفة واثقة، لا إعادات. الأكواريل فيه نور لا تعطيه الألوان السميكة. والطبيعة والضوء اللبنانيان، يناسبان كثيراً الأكواريل لأن الضوء المحلي يوحي لك أنه منقَّح. وهذا ممكن نقله مع الأكواريل. هذه الشفافية تناسب كثيراً رسم المنظر اللبناني» بحسب بعلبكي.
من رحاب الطبيعة إلى حميمية الداخل والأنا
«ما هو الفن الخالص نسبة للمفهوم الحداثوي؟ هو خلق سحرٍ إيحائي يَحوي في الوقت عينه الموضوعَ والفاعل، العالم الخارجي للفنان والفنان نفسه» (شارل بودلير).
يأخذنا الغوص بين المناظر الطبيعية، إلى حقلٍ آخر حيث أسامة هو العنوان الأبرز لأعماله. يراقب ذاته، يرسمها، ينتظر معها، يلعب… إلى أن يسحبنا الموج إلى منظر داخليّ في بيت الفنان، والأخير مُمدَّد على الأرض، خافياً رأسه داخل خزانة خشبية صغيرة، فيما اللوحات على حيطان المنزل داخل اللوحة. نميِّز منها أعمال أسامة كما أحد أعمال والده الراحل عبد الحميد بعلبكي: «هذه الأعمال الجديدة فيها استعداد للتحوُّل. لقد شبعتُ من العمل على المنظر الطبيعي، فعدتُ إلى المناخات التي فيها معايشة الداخل كأنها بيان للخارج، لكنه بيان بصوت كتوم مكتوم. ففيها الصمت، وهذا بيتي بحذافيره. اسم هذه اللوحة «الصور الشاهدة». هي عن حياة الرسام في بيته المليء بالعناصر. داخله تصبح اللوحات كائنات حية.

تصير كأنها تراقبك. وهذا التمدد (تمدد الفنان على الأرض في اللوحة) هو نتاج إنهاك لكن بشكل طريف، وفيه شيء طفولي، هو الرغبة بأن تحشري نفسك في زوايا آمنة. أحب الزوايا منذ الصغر، أجد فيها تقوى معينة، وتقشفاً، وملجأً. الزاوية توحي لي بالهرب من العالم الفضفاض. تحدد إحساسك وفيها شيء دينيّ. إذا هي مسألة البحث عن استراحة من عالم مضطرب أنتِ مترددة فيه، فالإنهاك موقف. والاضطراب هنا يتحول إلى تمدد. والتمدد والصلة المغناطيسية بالأرض، تخفف من إحساس عالم سريع. كأنك تثبتين نفسك خوفاً من أن يقتلعك الزمن. وهكذا تصبحين مثل علامة أو وتد ضمن الواقع. هذا التمدد فيه شيء حميمي وشيء من الاستراحة. فالعالم الجواني عدتُ إليه. ومهما غبت عن فكرة أن أراقب حياتي، فعندي إدمان على مراقبة أفكاري ووجودي في الوقت والمكان» وفق بعلبكي. لكن ذات الفنان ليست المحور الأوحد، إذ يضاف لها إعجابه بالرسّامين والرسم، لكن هذا الإعجاب لا يفوقه إلا افتتانه بالشعراء وبحياتهم! فهو قارئ للشعر. لذا فللشعراء حصة في أعماله، وفي ذا يقول: «الشعراء هم الأبطال المعنويون للعالم! وإذا كان هناك معنى للفروسية، فهم فرسان الإنسانية. الشعر موجود في رأسي، إلى جانب سير الشعراء الذين أحبهم. ولا أجد أفضل من استعادتهم رسماً. ما يقربني منهم. هناك قوة مغناطيسية في صورهم تشعرك أنهم باقون. فيهم شيء أزلي!».
تحليق خارج نمطية التمرُّد
«الفنان، الفنان الحقيقي، الشاعر الحقيقي، لا يجب أن يرسُمَ إلا كما يرى ويشعُر. يجب أن يكون مخلصاً حقاً لطبيعته الذاتية» (شارل بودلير)
عزفٌ منفرد، أو تحليق خارج السرب، هي أقرب الترجمات لعنوان المعرض من الترجمة المباشرة: «عكس التيار»، ما يلخص 10 سنوات من العمل المتواصل. أصبحت هذه الأعمال تشكل تجربة عملية، يمكن القول بأنها مسار جدّي حُرٌّ بكامل المعنى: «لست أعاكس التيار، بل أتيح لنفسي حرية الخيار، حرية المسير الحر. أن أرسم المواضيع التي أريدها.

هو تحليق منفرد خارج السرب. توهانٌ عن الركب. شرود واسترسال. فالاستفزاز و«القفشات» في الفن صارا تقليداً شائعاً نسبياً! لدرجة لم يعودا تمرداً، بل حالة جامدة. صارت حال الفن ساكنة بسببهما. أليست هناك طريقة ثانية كي يحاور الفن العين؟ برأيي، بلى يوجد. وما أحاول أن أقوله إنّ الفن فيه حساسية قادرة أن تتمدد عند المشاهد من دون أن تجرفه. فهذا الفن وهذه الأعمال ليس طموحها أن تجرف، بل أن تبهر! لذا هناك إبهار مغناطيسي يسيل. يأتي إلى العين بطريقة هادئة، دراماتيكية. هناك دينامية بطيئة توصل لك فحوى العمل». يشرح بعلبكي قبل أن يضيف: «طبعاً إذا قلنا أنك تكونين صوتاً منفرداً، ترَين حياتك والعالم بمنظار عينيكِ. ولكن هناك سلاسة في التعاطي، وحنان في استقبال الآخر. فهناك هذه النغمة الخافتة في الأعمال. صحيح أنها نغمة عكس السائد لكنها أعمال غير استفزازية. لدي إحساس أن الفنون الحديثة اليوم تركز نسبياً على الاستفزاز، فيما ما زلت أرى في عمل الفنان طاقة شاعرية وعاطفية! ما زلت مع الرسم. أحركه من داخله. الجديد بالنسبة إلي هو ما أحسّه. وليس الجديد الذي تفرضه هيمنة أفكار سائدة في الفن. وبهذا المعنى: هذا العمل وجودي!».
سينوغرافيا نوستالجيّة
«لقد قررنا أن نغرد خارج السرب مع أسامة من ناحية السينوغرافيا» يقول صالح بركات لـ «الأخبار». ويضيف: «العرض غير مينيماليّ ولا خطيّ. بل على الطريقة القديمة، حيث نجد لوحةً بمحاذاة الأخرى، أو فوقها. ثم ليس المعرض بموقع المعارضة، وإنما ذو حيز خاص في زمن أصبحت فيه الأولوية في الفن هي للناحية المفهومية. إلى درجة قد يضيع العمل الفني بذاته مقابل الديكورات والقصة/ السردية. اليوم هذا الفن النابع من الأحشاء وليس من العقل، يجعل من الممكن أن نعرض الأعمال بشكل مركب. فاللوحة قيمتها بذاتها، لا بسرديتها، وهي تدافع عن نفسها بنفسها». ما يؤكده بعلبكي: «هذا رسم لا يُمانع أن يكون طرباً. أجد أن العالم بحاجة للتشويق من جديد، للحماس، للعاطفة! تؤذيني أحياناً الصيغ الجامدة للتعامل مع الفن كأنه في مختبر طبي أو علمي. هذه النمطية تسلب الخيال الحُر متعة أن يستلقي بِحُرية. أنا ميال لشيء من التنسيق والفوضى. خليط منهما يخلق لذة الحياة ولذة الفن!».

ويضيف: «للمرة الأولى، أستطيع أن أرى أعمالي كلغة. ثم إنّ تصميم المكان والإضاءة المدروسة والمساحات المفتوحة الضخمة، تضعك في جو متحفي. أما طريقة التعليق، فكانت رؤية صالح (بركات)، وهي أن لا نعلِّق الأعمال بطريقة خطية. بل أن نقدم صيغة بصرية تشبه التشويق الموجود في الأعمال المتحفية. أعمال متراكبة، هناك إيقاع، لأنّ التعليق الخطي والصارم بات يليق أكثر بالفنون ما بعد الحديثة. فالتعليق المتراكب يضيف للفضاء اتساعاً، وتصير الأعمال تتحرك في إطار غير رتيب. هذه الرشاقة في التعليق تُنجي من التغليف والتعليب الطبي». لذا تركن في حيِّزها الشاعري الأبلغ. وفي ذا يختمُ بركات: «قد تكون أعمال أسامة جزئياً مبنية على الشعر القابع في مخزونه الفكري والثقافي. ولا شك أن هناك ايروتيكية ما، وشاعرية في ما يُقدِّم. إذ تشعرين بالألق والأرق وحتى النزق. المعرض هذا يُهدي مساحة من الحلم! نراها في عيون الزائرين.. خارجين وهم يحلمون».
* «عكس التيار»: حتى 25 آب (أغسطس) ــــ «غاليري صالح بركات» (كليمنصو ـ بيروت) ـ للاستعلام: 01/345213
فنان المرسم
«حزين هو الإنسان، إنَّما سعيدٌ سعيدٌ هو الفنان الذي تمزِّقه الرغبة والشغف!» (بودلير).
«كنت قد سألت أسامة عن موضوع يود معالجته لمعرضه القادم، فقال لي حينها إنه لن يصير فناناً من هذا النوع إطلاقاً! ولا أن يعمل على ثيمة معينة واحدة. فهو فنان يستيقظ صباحاً، يشرب قهوته، ثم يذهب كل النهار إلى محترفه ستة أيام في الأسبوع. ليس الموضوع ولا القصة ولا السردية هي الجوهر، «المشترك هو أنا» قالها لي». هكذا يبدأ صالح بركات وصف عالم أسامة بعلبكي الفني. ما يؤكده الأخير لـ «الأخبار» بإجابة مسهبة عن علاقته بمرسمه وكيفية الرسم: «أقيمُ اعتباراً كبيراً للمرسم. هو عزلتي الحياتية وعزلتي الفنية. المرسم تجويف دماغي يحوي الخيال. حيطانه هي الحدود بين خيالك والخارج! فالمرسم فيه طقس. وأنا ما زلت أتعامل مع المرسم كأنه طقس. فيه شيء كيميائي، فيه استحضار. كأنه عالم، لكن هذا العالم ليس بارداً، بل عالم مشحون بالعواطف. أرسم. والرسم عندي لُحمة واحدة من خط ولون.
الاستفزاز و«القفشات» في الفن صارا تقليداً شائعاً، إلى درجة لم يعودا تمرداً
لذا هناك اندماج كبير في سبك الخط واللون في الأعمال وهي نتاج تربيتي الأكاديمية والواقعية. ما يجعل الخط واللون مطعمين وموقعين بطريقة فيها سبك، مقنعة. اللذة التي أشعر بها عندما ألوّن على الباليت، هي لذة قريبة للّذة اللسانية، للطعمة. فأنا ألوِّن بشغف. وكلما أخرج من عمل، أعد نفسي بتنفيذ عمل جديد، لأنني أعدها بسعادة ستقوم مع النهار الجديد. هناك فرح، وعصب مشدود ومخيلة أصبحت مربوطة بالأسلاك الكهربائية باليد. وهذه المخيلة مع قربها من اليد تجعل كل نبرة، وكل ضربة هي نبرة عاطفية مشبعة. والسبك هو نتاج توحدك مع الذات. ونتيجة توحدك مع ذاتك ونسيانك للتوترات، يطلع اللون. أنا أطلب أن يكون اللون منحوتاً، وهذا ما تبنيه لديك طريقة العمل الانطباعية. أن يكون اللون بالضرورة مسبوكاً ومبرياً. واللون لا ينوجد اعتباطياً، بل ينوجد لأن هناك إرادة. ولأن هذه الإرادة يجب أن تمرِّن عضلة اللون، فيصير حاراً! نوره صادر منه. لا مجرد إضاءات فيها تكلف أو إحساس بنفاد صبر. فاللون على العكس مقنع، كأنه معمول بعاطفة، بشغف. في المرسم أشعر أنني أرسم بيدي وبأسناني وبعيوني. فالرسم أداء جسماني بهذا المعنى. هو عمل عاطفي وحسي».
 موقع هوا لبنان
موقع هوا لبنان