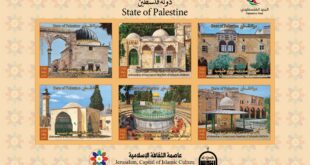“جلال خوري” ركن هوى من المسرح اللبناني
عن 83 عاماً غيّب الموت المسرحي اللبناني الكبير “جلال خوري” بعد حياة معطاءة فنياً على مدى 55 عاماً، شارك خلالها في الحركة المسرحية الجديدة التي إنطلقت مطلع الستينات مع كبار( منهم:روجيه عساف، منير أبودبس، ريمون جبارة، نضال الأشقر) من فناني تلك الحقبة، وكان ممن ترجم الكثير من النصوص الأجنبية وقدّمها على الخشبات اللبنانية المختلفة، وعرف بأنه ودود، ذو طبع سمح، وصوت خفيض رغم طوله الفارع، وعرفه تلاميذه ما بين جامعتين: اللبنانية، والقديس يوسف، بالمشارك لهم في نشاطاتهم، وحتى في رحلات الترفيه التي ينظمونها من وقت لآخر.
المخرج الراحل كان باحثاً إلى جانب عمله الميداني. إرتبط بالثقافتين الإنكليزية والفرنسية بشكل وطيد وعميق، وكانت الغاية فقط ضخ الثقافة العربية بهذين الرافدين الثريين، وليس اللجوء إليهما بديلاً للغة الضاد والمشتغلين بها، مما عزّز ميدانياً التزاوج الحضاري، وأثمر أعمالاً لها وزنها ما زال صداها الإيجابي يتردد منذ عشرات السنين وحتى الآن، في محاولة لرأب الصدع الثقافي الموروث من شريحة معطاءة، لأي إحتكاك أم مصاهرة مع الثقافات المتقدمة في العالم، ولم تكن معركة “جلال” صعبة في ذلك الوقت، لأنها تزامنت مع ظروف سياسية في المنطقة حتمت إبراز لبنان لوجهه الحضاري ثقافياً لكي يحتل مكانته المرموقة على خريطة المنطقة.
الأستاذ الجامعي، الباحث المغرّد لوحده في سرب خاص، المخرج الموسوعي الذي كان الأجرأ بعد طي الحرب على لبنان لصفحتها الدموية، عندما قدّم المسرحية الرائعة “بنسيون الست نعيمة” عن نص لـ “أسامة العارف” وبطولة موفقة جداً للزميل “عبيدو باشا” في دور منظّر وطني ضد الإنعزالية والصهيونية، يصطدم بواقع غير مسبوق حين تجتاح القوات الإسرائيلية بيروت، ويدخل جندي إسرائيلي شاب يسأل عن إسم يعمل في البانسيون الذي يديره “عبيدو”، وعندما يلتقيان يتبين أن المنظّر الوطني خاض علاقة مع شابة بولندية وأنجبت صبياً ها هو اليوم جندي في “جيش الدفاع الإسرائيلي”. إلى ذلك في سجل “جلال” أعمال بارزة أخرى، كالتي أخرجها أولاً عام 62 بعنوان “الرفيق سجعان”، ثم تميزت له أعمال أخرى( شكسبير إن حكى، خدني بحلمك مستر فرويد، وفخامة الرئيس) وكان خاض تلاسناً مع مدير مسرح “مونو” “بول مطر”، بشأن كيفية دفع بدل إستئجاره لصالة المسرح، وتردد أن مخرجنا تعرض لبعض اللكمات من مطر.
“جلال خوري” يغيب، هذا يعني أن خسارة كبيرة تعرّض لها المسرح اللبناني، لمخرج لم يكن يغيب عن العرض الأول لأي مسرحية يُدعى إليها، وكان يحضر ومعه كاميرا فوتوغرافية محترفة، يرصد بها أهم المشاهد ويحتفظ بها في أرشيفه، وهو بالمناسبة صاحب عين بالغة الحساسية في إلتقاط ما يريد تصويره. يرحل “جلال” والصحة لم تكن متوعكة، بل هو القضاء والقدر وحسب.
نبذة (هوا لبنان)
ولد فيبيروت، كاتب مسرحي، مدير مسرح، محرر كوميدي وفني.
أول كاتب مسرحي لبناني يترجم وينفذ دوليا، وترجم أعماله إلى الألمانية والإنجليزية والأرمنية والإيرانية والفرنسية. لعبت مسرحيته “رفيق سيجان” لفصلين متتاليين في فولكستيتر روستوك. يعرف خوري بأنه المروج السياسي في المسرح في الستينيات من القرن الماضي، وهو أيضا عالم إيثنوسينولوجيست. وقد شارك في العديد من الندوات في باريس والمكسيك حول إثنوسينولوغي، وهو الانضباط الجديد الذي يمثله في لبنان. خوري هو أيضا مؤلف عدة أوراق عن المسرح والفنون باللغتين الفرنسية والعربية، ونشرت في لبنان والخارج، فضلا عن كمية من التعديلات الخلابة ونظرية الكتابات الحرجة باللغتين الفرنسية والعربية، وظهرت في العديد من الدوريات والكتالوجات.
- المحرر الفرنسي الفني (لي سوير، L’أورينت ليترير، مجلة …) في 1960s.
- يبدأ حياته المهنية المسرحية في عام 1962 داخل مسرح الكلية الفرنكوفونية في إطار المدرسة العليا ديس ليترس (مركز ونيفرزيتير d’études دراماتيكس – C.U.E.D.).
- يبدأ حياته المهنية توجيه في عام 1964 مع “برتولت بريشت”رؤى سيمون ماشارد”. يعلم المسرح في الجامعة اللبنانية (كلية الفنون الجميلة) من 1968 حتى 1975.
- مؤسس ورئيس المركز اللبناني لمعهد المسرح الدولي (اليونسكو) من 1969 حتى 1984.
- رئيس اللجنة الدائمة لمعهد المسرح الدولي في العالم الثالث من عام 1973 حتى عام 1977.
- يعلم المسرح (النظرية والممارسة) وكتابة السيناريو في جامعة سانت جوزيف (معهد الدراسات الفنية، أوديوفيسويلس و سينيماتوغرافيك) من 1988 حتى 2012.
- رئيس قسم الدراسات ذات المناظر الطبيعية الخلابة في جامعة القديس يوسف (معهد الدراسات الفنية، أوديوفيسويلس، سينيماتوغرافيك) من عام 1988 حتى عام 1999.
وكتب عقل العويط في “النهار”
كان لا بدّ له، أولاً بأول، من أن يستعيد عمله البكر، “وايزمانو بن غوري وشركاه”، عن نشوء الكيان الصهيوني، وأن يلقي السلام على “الرفيق سجعان”، ولم تكن لتفوته فرصة أن يشاهد، وإن من وراء الكواليس، متلصصاً عبر فتحة قليلة في الستارة، تلك المحاورات الممتازة بين “شاهين وطنسا”، في المسرحية التي اشتهرت بعنوانها الأغرّ، “كذّاب”.
كان عليه أن يتذكر “فخامة الرئيس” – مَن لا يتذكر “فخامة الرئيس”؟ – في عزّ العنف الأهوج والرهبة الحربية المرعبة واليد الميليشيوية على الحياة والخارجين على القطيع، من دون أن يغفل تزجية الوقت برؤية أرتورو أوي في صعوده “الهتلري” الميمون، مأخوذاً بطريقة بريشت، وموصوماً على مستوى المضمون بأوجاع القضية الفلسطينية، وهزيمة 1967.
كان الخيّاط المسرحي باسقاً كشجرة سرو، ويسارياً أيام كانت النفحة اليسارية توحي الاعتزاز والكِبر، وكان فرنكوفونياً بامتياز، منذ أن عمل في “المسرح الوطني الشعبي” في باريس، ثمّ في “المركز الجامعي للدراسات المسرحيّة”، مقترحاً منذ البداية، وبالفرنسية، “في انتظار غودو” لبيكيت، التي حظيت بنجاح ملحوظ.
لكن المخرج الطليعي شاء ألا يبقى زاهداً بالجمهور العريض، فجرّب الأعمال الفودفيلية، التي مال فيها إلى البعد الشعبوي، في اقتناص ضحكة الجمهور وتصفيقه، ربما بسبب ما كان يستشعره من رهاب المأزق الذي وقعت فيه الأعمال الطليعية لدى اصطدامها بأمزجة الناس.
وحين كرّت أعمال من مثل “يا ظريف أنا كيف” (1992)، “رزق الله يا بيروت” (1994)، “هنديّة، راهبة العشق” (1999)، “الطريق إلى قــانــا” (2006)، و”رحلة مُحتار إلى شرْي نَغار” (2010)، كان لا بدّ للمُشاهد من أن يعاين الفرق بين البدايات وأيام الزهو، وبين النهايات، وخصوصاً بعد تطليق جلال خوري الطليعية التجريبية، لينصرف إلى بعض التبسيط المسرحي الشعبوي، في خلطة لم تحصد الكثير من الإجماع حولها، بل الكثير من الانتقاد.
أمس، دخل الخيّاط الماهر ليله، وبقي فيه. المهرة الخيّاطون الروّاد لم يبقَ منهم إلاّ قلائل. وهم سيغادروننا واحداً تلو آخر. للأسف، لن يعطى لأحدٍ منهم بعد وقت، قد يكون قصيراً أو طويلاً، أن يظلّ شاهداً. ذلك كان زمناً بيروتياً عزيزاً، في طريقه إلى الأفول.
أعرف أن جيلاً مسرحياً مخضرماً، يشغل اليوم مسارحنا، ويحييها من جديد، بنفحات وبصمات مختلفة، ترافق طباع العصر وأمزجته وهواجسه، في الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا والكتابة.
هذا الجيل المخضرم والجديد، لا بدّ من أن يلقي التحية على الخيّاط الراحل، آخذاً من يده أسرار الخياطة وفنونها، وما ينبغي له أن يتعلّمه منه، متطلعاً إلى غدٍ مسرحي أفضل، وإلى خياطةٍ لا بدّ أن تلائم جسد هذا الزمن السوريالي الجديد وقوامه غير المسبوق.
akl.awit@annahar.com.lb
 موقع هوا لبنان
موقع هوا لبنان